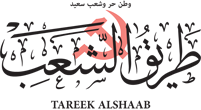نشرت جريدة طريق الشعب الغرّاء مقالًا، عنوانه :(مازال سلطان الحريم فاعلا وإن اختفى حريم السلطان ) للكاتب جمال العتّابي، في : 6_ ذار _ 2025. ضمن المقالات التي عزمت الجريدة الرائدة على نشرها كاحتفاء بيوم المرأة العالمي.. وفي حقيقة الأمر أنني وجدت في المقال ما يفتح شهية الرد، والنقاش والتحاور مع ما تضمنه من موقف (حتمي!) تجاه المرأة، بأسلوب تقريري، يعتمد على حشد الآراء المتباينة لتبني موقفًا مضمرًا وكامنًا، بين سطور النص . وسأحاول أن أفكك البنية التعبيرية لأبرز الأفكار الواردة فيه من خلال النظر في البنية اللغوية التي جسدت أفكار الكاتب.
كان العنوان_ لوحده _ كفيلًا بالنظر والتأمل، والتوقف عند دلالته الصحفية؛ فالعنوان عتبة رئيسة، للإعلان عن توجه النص ورؤيته الثقافية، ومن هنا وضع جيرار جينيت رباعيته الشهيرة في خصائص العتبة الصغرى ( العنوان ) وهي باختصار : التعيينية، والإيحائية، والوصفية، والإغرائية . واشتهرت هذه الخصائص الأسلوبية مع شيوع مصطلح ( النص ) بوصفه نظامًا لغويًا مبنيًا على وفق سياق مرجعي يحدد العلاقة بين المرسل والمرسل إليه.. ولو نظرنا إلى عنوان مقالة العتابي لوجدنا ارتباكًا في تحديد دلالة النص الكلية ورؤيته الخاصة.. وتبدو الضبابية في العلاقة الإسنادية بين (المضاف والمضاف إليه) فسلطان الحريم البنية اللسانية المبتدئة في تحديد العلاقة تبيّن أن الطرف الأول (الذكوري) مضاف إلى دال أنثوي (حريم) بمعنى أن القوة الدلالية تتمركز حول الأنثى، التي أضيفت لها وظيفة (السلطان) بكل ما يحمله هذا الدال من شحنات رمزية ذات دلالات سلبية .. فنقول مثلًا (قلم الطالب) أي أن المالك للطرف الأول _ النكرة _ هو الطرف الثاني _ المعرفة _ فيكون القلم ملكًا للطالب وليس العكس، ولو عكسنا العلاقة الإسنادية وقلنا (طالب القلم) لانقلبت الدلالة رأسا على عقب .. وهنا لا أفهم ما جدوى أن تكون العلاقة الإسنادية الأولى
(سلطان الحريم) في مقال لم يتحدث إلا عن الموقف الذكوري السلبي من المرأة : قديمًا وحديثًا . ولم أجد في المقال ما ينبئ عن السلطة العليا للمرأة .. وأما الطرف الثاني من المعادلة النصية العتبية (حريم السلطان) فهي أيضًا غائبة عن مضمون النص لأن المقال معني بكشف موقف (الرجل) من (المرأة) وهو عنوان شائع ومألوف ويومي، يُنسَب إلى المسلسل التركي، الشهير الذي يحمل العنوان نفسه. فضلًا عن ذلك فإن مصطلح (الحريم) هو مصطلح ديني، وقبلي؛ يُنسِف _ مسبقًا _ أي موقف إيجابي يمكن أن يكون مع (المرأة) إذ إن مفهوم الحرمة يكفي أن يضعها في الحقل السلبي سواء كانت مضافة أم مضافة إليه؛ حسب دلالة العنوان .
وفي متن المقال عمد الكاتب إلى (الإعلان) المسبق للحديث عن ان ((خصوم المرأة لا يرون في المرأة أية ميزة، إنها في نظرهم إنسان مختلف ومتخلف أيضاً، أو أنها بتركيبها المعقد أسهمت في تشوش النظرة اليها، وأنصارها يرون أنها لا تختلف عن الرجل، هي أقدر على احتمال الألم والمرض، وأطول عمراً من الرجل، يدفعونها إلى الحرية والعمل. وعشّاقها يرون فيها ينبوعاً رائعاُ للجمال والمتعة، و الحياة بغيرها مستحيلة، وان السماء قد أهدت البشرية حواء وبناتها لإشاعة الحب في العالم)). وأحسب أن هذا التقسيم الثلاثي الجاهز لأي ظاهرة في الحياة، هو تقسيم إنشائي، وتقريري! فمن هم الخصوم؟ وأسلوب الجمع ممن يتكون ؟ فقد ترك حبل المعنى طليقًا على غاربه ! ومَنْ هم أنصارها ؟ وعشاقها ؟ سيقول القائل إنه يقصد توزع النظر إليها بين هذه المواقف الثلاثة؛ وسأجيبه أنني بالإمكان أن أقول القول نفسه عن : الرجل / العلم / الثقافة / المال / ..) أستطيع أن أقول أنصار المال كذا وخصومه كذا وعشاقه كذا .. وقد يحسب القارئ أنني أتحامل على الكاتب العتابي في هذا الموقف، غير أنني ما كان موقفي من المقال بهذه الصورة لولا أنني وجدت جلّ ما سطره هو موقف الفلاسفة السلبي من المرأة؛ فراح يبحث في شرق الفلسفة وغربها عن أقوالهم (الانتقائية) ذات النظرة العدوانية للمرأة / الحريم ! ومن دون أن يذكر مصدره الفلسفي أو الكتاب الذي اعتمد عليه في انتقاء الرأي.
ذكر الكاتب رأي أرسطو، ولكن هل يعلم أن هذه الرؤية قد قالها في كتاب (السياسة) وإنه تحدث بصورة متجردة للتعبير عن الموقف السياسي العام وليس عن المرأة بوصفها ظاهرة اجتماعية كما يوحي مقال العتابي، والغريب أنه فهم موقف أفلاطون فهما قاصرًا أيضا. فهذا الفيلسوف قد طرد الشعراء من جمهوريته! ولكن هل يقال أن أفلاطون ضد (الشعر) ؟ بالتأكيد كلا، لماذا لأنه هو بالأساس شاعر وإنما طردهم على وفق نظريته الخاصة المتكئة على رؤية المحاكاة.. وإلا فإن لأفلاطون موقفًا سلبيا من الديمقراطية، بسبب هزيمة أثينا على يد إسبارطة. إذن رؤيته ضمن فضاء فكري محدد وليس موقفًا متجردا كليا . والموقف نفسه ينطبق على رأي نيتشه، الذي دوّنه العتابي من دون أن يذكر أن هذا الفيلسوف الخطير إنما قصد (الخيبة الوجدانية) وليس المرأة بوصفها فتاة أو كائنًا اجتماعيا.
وأما قول شوبنهاور فهو موقف يتعلق بتجربة سايكولوجية وردة فعل على زواج أمه من صديق أبيه.. ما أعنيه، فيما تقدم ذكره أن الكاتب جمع أراء مختلفة وحشدها في سلة مقالته، من دون رؤية موضوعية وعلمية ونقدية تفرز خصوصية كل رؤية فلسفية . ناهيك عن موقفه من ابن رشد، الذي يعدّ إمام التنوير العربي والغربي والفيلسوف الذي واجه الظلامية (الذكورية) الفقهية في آرائه الشجاعة.. وأعتقد أن قيمة هؤلاء الفلاسفة تكمن في ثورتهم ضد الخطاب الديني، الذي يعدّ العتبة الأولى في خلق ظاهرة (حريم السلطان).