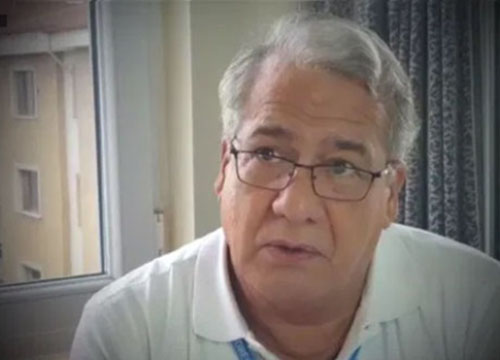لم أتبين ملامح السائق الَّذي جلستُ إلى جواره، غير أن شعر رأسه أبيض وكان متشبثاً بمقود سيارته مثل شبح يقبع في الظلام.
ليلة ماطرة لا أثرَ للنجوم فيها، تشوبها صُفرةٌ باهتة من أضواء المدينة التي انعكست على الغيوم الخفيضة. أحيانا تَمرُ بيّ لحظات من هذا النوع المماثل الَّذي يجعلك تشعر بأن لحظات مشابهة قد مرَّت بك في وقتٍ ما من أيامك الماضية، وهي بالنسبة لي، لها ذات اللون المصفَر والطعم الحريف والرائحة المثلوجة لمشرحة الجثث المجهولة، فأشعر أن قلبي يزن رطلاً وأنني على وشك تقيؤ أمعائي التي، يُخيّل إليّ دائماً، في مثل هذه اللحظات، انها قد امتلأت بسائل أصفر مرير كأنه الصديد الَّذي رأيته يسيل على أرضية المشرحة الباردة، يوم تعرفنا على أخي (وسام) وهو ممدد هناك مثل تمثال من الشمع الأصفر وقد افتر ثغره عن خطوط باهتة لهذا النوع من الابتسام الَّذي تركه عمداً فوق شفتيه لكيلا نعتقد بأنه عانى وتعذب كثيراً قُبيل مصرعه، بَعْدَ أن نادى علينا طويلاً وهو في عِزِّ رمقه الأخير إذ قالوا لنا إنَّه كان يمسك برأسه حين عثروا عَليه، فتكت بها شظية طائشة وتركته يرفس هناك وحيداً في العراء الَّذي يكتنفه الظلام.
-يا عَم، هل سبق لك أن رأيت الموتى؟
قلت للسائق الَّذي لم يردّ عليّ، وأغلب الظن انه لم يسمعني لانشغاله بشرود عميق تحت وطئة القعقعة الضاجة لمفاصل سيارته القديمة نوع (فولغا)، شممت فيها رائحة تبرز قديم أو روث حيوانات، ولمّا التفتَ إليّ أخيراً، كان قد مضى على سؤالي وقت طويل، إذ قال كَمَنْ صحا من غفوة:
- ها ؟ ماذا؟ ماذا قلت ؟ هل قلتَ شيئاً يا فتى ؟
قال ذلك وهو يوزع نظراته بين الطريق وبيني، لهجته سريعة وبصوت عال لأن ضجيج سيارته قد تركه تحت تأثيرٍ ما وأصبح لابد له من الصياح مثل عفريت حتى يسمعه الراكب المجاور، إن سائقي التاكسيات يضطرون طيلة النهار للإستماع إلى أحاديث الأغراب وبسبب من ذلك تجدهم يتحولون إما إلى ثرثارين أو صامتين غير مبالين بِما يدور حولهم، و ربما يكون هذا الرجل مصاباً بنوع من الصَمَم الَّذي سبّبه ضجيج سيارته طيلة سنين، فحاولت مجاراته ورفعت من نبرة صوتي مثله لأقول له:
- يا عَم، قلتُ لك، الموتى، هل...؟
قاطعني وقد انتابته حالة من التوتر العجيب، ويبدو أيضاً انه لم يسمعني جيداً إذ صاح بأعلى من السابق :
- يا الهي! الموتى ؟! ما الَّذي قاله لك الموتى يافتى؟!
- يا عم أقصد هل سبق لك أن...؟
- ماذا ؟ هل قلتَ سبقَ ؟ مَنْ يسبقُ مَنْ في هذا المطر ؟! يا إلهي لقد جَنَّ الفتى!
ضرب مقود سيارته بكلتا يديه !
- حسناً، اهدأ يا عَم أرجوك، أقصدُ هل رأيت...؟
- رأيت؟! هل قلتَ رأيت ؟ مَنْ رأى مَنْ ؟ يا رب! بحق النبي هل أنت مخمور يا فتى أم أنك مصاب بالهذيان ؟
كان يصيح بأعلى صوته وهو يهز يده اليمنى مستهزئاً تارة ومنفعلاً أخرى ثم يضرب مقود السيارة بكلتا يديّه. حينذاك فقط تأكد لي بما لا يقبـل الشك، من أنني متورط تماماً حتى خُفتُ من أن يفقد السيطرة على سيارته وينحرف بها في أية لحظة نَحوَ احد الأعمدة الكهربائية الممتدة على جانبي الطريق.
كأن سؤالي جاء لاستكمال ما ينقصه من حريق فاشتعلت أعصابه مَرَّة واحدة ولا سبيل لإخمادها. كان الرجل من هذا النوع الَّذي يعاني، بلا شك، من عصابٍ ما، ومن الصعب على أي مخلوق مواصلة الحديث معه في تلك اللحظة، فلكي تجعله يفهم ما تقصد، عليك أن تصرخ مثله كالمجنون، وهكذا ملتُ برأسي مقترباً وصحت في أذنه اليمنى بأعلى ما استطعت في محاولة أخيرة:
- يا عَم أردت أن اعرف فقط ما إذا كنت قد رأيت احد الموتى. .. الموتى...
رددت الكلمة الأخيرة طويلا.
هنا خَمدت أنفاس الرجل كأنّه غطس في بحرٍ من الصمت أو ربما مات فجأة، وظلت السيارة تسير مع استقامة الشارع، لكن عندما راح يسارقني النظر ويرمقني بنظراته الجانبية رأيت لمعانها الغريب في طرف عَينَيِّه من أضواء السيارات المارقة برغم عتمة المكان فتأكد لي أن الرجل حي يرزق. ، كان مرتاباً إلى ابعد حدود الريبة، فتبادر إلى ذهني انه قد يوقف السيارة ويطلب مني المغادرة الفورية بلا نقاش، أو يرتكب طيشاً كلانا في غنى عنه، لأن نظرته لم تكن من هذا النوع الَّذي يبشر بخير وكذلك صمته المفاجئ، حتى أن لحظات صمته التي طال أمدُها، جعلتني على يقين تام من أن الرجل يفكر بما قلت. بدا للوهلة الأولى وكأنه يعيد ويتفحص ويدقق ليتأكد ما سمعه مني أخيراً ولم يرد عليّ بحرف واحد. ربما سيجيب على سؤالي لحظة أخرى. مَنْ يدري ؟ لعله أهمل الموضوع برمته وآثر الصمت حفاظاً على هدوء أعصابه بَعْدَ أن اكتشف غرابة سؤالي وربما أصبح أيضاً على يقين راسخ بأنني مجرد معتوه وأن سؤالي هذا لم يسأله أحد ؛كأنما هبط عليه من السماء في هذه الليلة الماطرة، لهذا أو ذاك قرر أن يتجنب مواصلة الحديث معي و يتركني وشأني لكيلا أتمادى واطرح عليه سؤالاً آخر قد يؤدي بي أو به إلى التهلُكة، فرحتُ أُشاغل نفسي طيلة مدة صمته، بمراقبة المشهد الليلي الَّذي يتشظى بأمطاره على الزجاجة الأمامية ويسفر عن عشرات من الوجوه بملامح من ماء وضياء، ما أن تسيل هذه الوجوه على الزجاج حتى تُسرع ماسحتا الزجاج إلى إزاحتها نَحوَ الجانبين ثم ماتلبث أن تتشكل وجوه أخرى بالملامح المائية نفسها وعلى محياها ذلك النوع من الابتسام اللاصِف مثل صف طويل من الأسنان، وشرعتُ أتساءل هامساً مع نفسي وبصوت مسموع، مادام الرجل ثقيل السمع فلِمَ لا آخذ حريتي في الكلام : أتراه يرى ما أرى وتتراءى له مثل هذه الوجوه ؟ وهل تسربت سيول هذه الأمطار الغزيرة الليلة هذي إلى سراديبهم ؟ أتراهم خرجوا الليلة إلينا يحتمون بنا؟ وهل يبردون ويتذكرون لياليهم الدافئة معنا ؟ كان أخي (وسام) لا يتدثر إلا بلحافين وينادي على أمي أن تجلب له بطانية إضافية، تضحك أمي منه وتناديه باسم الولد العجوز، لو قُدر لك أيـها السائق أن تـرى أخي(وسام) لأدركت في الحال أي مخلوق رقيق وجميل هو؛ مثل عصفور وديع، كُلَّما أقف أمام المرآة التي كان يقف أمامها، يتراءى لي وجهه الوضّاء محتجباً و أتساءل ما إذا كانت المرايا تحتفظ ببقايا ملامح الإنسان في غيابه. وكنت أتساءل أيضاً أين تذهب العصافير إذا ما أمطرت وأظلمت الدنيا وهي بعيدة عن أعشاشها؟ هل تستضيفها العصافير الأخرى، أم تموت على إسفلت الطريق؟
وفي لجة تلك التساؤلات، توقفت السيارة فجأة !
يبدو أنني وصلت إلى عطفة الزقاق وأنني أعلمت السائق بوصولي دون أن ادري. كنت على وشك النزول عندما أعطيته إجرته مودعاً، لكن الرجل أطفأ محرك سيارته على نَحو غير متوقع وأسند رأسه على المقود وراح في نحيب عجيب ! حتى أن كتفيّه اهتزتا من فرط البكاء. كان يتحدث بصوت نادب تخنقه العبرات وهو يقول لي كمن يجيب على سؤالي أخيراً :
“نعم، نعم، لقد رأيت، رأيت ولدي ذات يوم وعلى وجهه هذا النوع نفسه من الابتسام!”