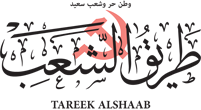في جلسة مع أصدقاء مصريين مثقفين ومنخرطين في الشأن العام من أبناء جيلي، دار حديث عن الدور الذي لعبه جمال عبد الناصر في التاريخ المصري الحديث. قال أحدهم، ووافقه على ذلك زملاؤه الحاضرون، إنه ما كان سيتيسّر له شخصياً أن يدخل المدرسة، ومن بعدها الجامعة، ليتخرج منها في مجال اختصاصه، وأن يشق لنفسه درباً للمعرفة لولا التعليم المجاني الذي جعل منه عبد الناصر واقعاً بعد أن كان فكرة في أذهان رجال التنوير في مصر، وفي مقدمتهم طه حسين. وما التعليم المجاني سوى أحد منجزات عبد الناصر، التي لا ينكرها إلا الجاحدون، هو الذي عزز مكانة مصر ودورها عربياً وأفريقياً، لا بل وعالمياً، من دون إغفال الثغرات ونقاط الضعف في النظام الذي أقامه.
على صلة بهذا طالعت منشوراً للشاعر والأديب العراقي الصديق حميد قاسم، كتبه بمناسبة الذكرى السنوية للحدث التاريخي الكبير الذي هزّ العراق، وأخذه إلى مساق آخر في 14 يوليو/ تموز (1958)، وقاده عبد الكريم قاسم، وحوله اختلف المختلفون بين من يصفه بالثورة، فيما يراه آخرون انقلاباً عسكرياً. (يدور السجال نفسه بشأن ما جرى في مصر في 23 يوليو/ تموز (1952) في مصر، الذي لولاه لما أصبح عبد الناصر رئيساً لمصر). أصدر قاسم قانونين مهمّين غيّرا بنية المجتمع العراقي، قانوني الأحوال الشخصية والإصلاح الزراعي. وربما كانا من أسباب الانقلاب عليه وقتله.
وكما قال الصديق المصري عن فضل عبد الناصر عليه، كتب حميد قاسم، مخاطباً "الزعيم" قاسم: "لولاك لما كنتُ أنا، لا كتبت يداي حرفاً، ولا تعلمتُ ولا أحببتُ ولا درستُ ولما كنتُ أنا حميد قاسم. بعد هذا كله، ليس من المروءة أن أنكر ذلك أو أتجاهله أو أتناساه، يا زعيم القلوب المكلومة المحبّة المكسورة والطيبة". وخاطب من وصفهم بالليبراليين الذين لا يحبّون قاسم ويحمّلونه مسؤولية ما آلت إليه أوضاع العراق في العقود التالية، قائلاً بلهجة عراقية: "لولا قاسم و14 تموز كان أنتم بعدكم أميّين لا قراية ولا كتابة.. تتمسّحون بحجارة يابسة بالچول، وخدم عند شيوخ إقطاع التفاهة العثمانية - البريطانية".
أثار هذا المنشور ردود فعل متباينة، بين من أيد ما جاء فيه وحيّا شجاعة كاتبه في الدفاع عما يعدونه حقاً، ومن أبدى تحفظات على ما ورد فيه. ويلفتنا الرد الذي ذهبت صاحبته، فاطمة المحسن، إلى رفض نسبة ما تحقق للعراق بعد "14 تموز" إلى شخص عبد الكريم قاسم، فما جرى يومها كان "من نتاج حركة الشارع العراقي بأكمله، وكان لا بد أن تتّخذ حكومتها خطوات لخدمة الناس الذين أيدوها وفي مقدمتهم فقراء الأرياف والمدن، ثم إن حكومة قاسم التي تشكلت معظمها من الاشتراكيين هي التي اتخذت هذه القرارات، وليس قاسم وحده". تقودنا مثل هذه السجالات إلى تجربة بلد عربي آخر، مغاربيّ هذه المرة، هو تونس، الذي تنسب إلى الحبيب بورقيبة مؤسس الجمهورية فيه مكتسبات كثيرة، في مقدمتها ما تيسر للمرأة من تمكين وحقوق، ما زالت آثارها بينة. وحول هذه النقطة بالذات، لا يوافق كثيرون على نسبة فضل تحرير المرأة التونسية إلى بورقيبة وحده، فالطاهر الحداد وأبو القاسم الشابي وصليحة (مغنية تونسية) وغيرهم مثّلوا "جيل النور الذي دفع الديجور"، كما علقت الأديبة نورة عبيد على مقال سابق لي في هذا الخصوص، بينما كان دور بورقيبة سياسياً بعد وصوله إلى الحكم في الخمسينيات، ما مكّنه من وضع التشريعات والسهر على تطبيقها في الدولة التونسية الناشئة.
نخلص من هذه الأمثلة إلى أن الدور المؤسس أو المغيّر لأي شخصية، يلزمه ظرف موضوعي مهيأ للقيام بما يقوم به، يتمثل بجاهزية المجتمع المعني للتحول المنشود، عبر تراكم تاريخي حتى تحين لحظة التغيير، حين يتيسر للأمم "المحظوظة" زعماء قادرون على التقاط تلك اللحظة وإحداث النقلة النوعية المنتظرة. يصح هذا على عبد الناصر وعبد الكريم قاسم وبورقيبة ومن هم في مقامهم، حين يقترن القرار السياسي بفكر تنويري يجسده على أرض الواقع بتشريعات وآليات تضمن تطبيقها، فالتغيير ليس مجرد حدث سياسي، بل تجسيد لحدث فكري يقوم به فاعلون سياسيون يحملون الرؤى الفكرية نفسها ويعون أهميتها.
ودون ذلك، ستبقى الأفكار العظيمة حبيسة الأذهان إن لم تجد إرادة وإدارة سياسيتين تحولانها إلى واقع، عبر القوانين والتدابير.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
"العربي الجديد" – 20 تموز 2025