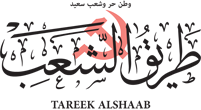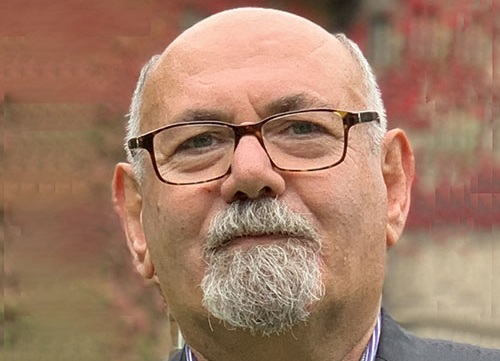جاء أعرابي إلى المأمون وهو في رحلة صيد، وأهداه قربة ماء جلبها له من غدران الجزيرة، سائلاً منه مكرمة مقابل "ماء الجنة" هذا. وجد الخليفة الماء مالحاً، فابتسم في سره وأمر الحاشية أن يملؤوا قربة الإعرابي ذهباً، ويرافقوه إلى الصحراء، وشدّد عليهم أن يمنعوه من دخول العراق، إذ لن يستطيع أحد حينها إبقاءه تابعاً مطيعاً، إذا ما ذاق ماء الفرات.
لا أدري ما إذا كان المأمون مدركاً لعلاقة الوعي بالواقع، الا أن هذه الحادثة تمثل حكمة، أعطت الماركسية تعليلها العلمي بعد قرون، حين أثبتت بأن اختلاف الظروف يغيّر من وعي البشر، ويجعل بالتالي من تبني معالجات مختلفة للقضايا الاستراتيجية، بدءاً من الشعارات ومروراً بالتنظيم وانتهاءً بأساليب الكفاح، أمراً جوهرياً، تنهار بدونه السقوف وتتعطل بوصلة المسار.
وتمثّل أول إقرار بهذه القاعدة، في مساحة التنوع التي وُضعت في البيان الشيوعي وخلقت الفرص لتطوير الممارسة وفق متغيرات الواقع، وفيما ضمّته الأممية الأولى من تيارات، لم يكن يجمعها الكثير غير السعي لإنهاء الانقسام الطبقي وإلغاء الرأسمالية. كما تم تبنيها بعد ثورة أكتوبر، فرغم ما تميزت به نظرية الحزب اللينينية، من مركزية خاصة فرضتها الظروف الاستثنائية الموغلة في القمع والحرب الأهلية والعدوان الخارجي، سارع البلاشفة لاحقاً للتعامل بمرونة سياسية وتنظيمية تتناسب مع تغير الظروف، فتحوّلوا إلى حزب جماهيري كبير، قبل أن تَئِد الستالينية تلك المرونة وتحل قرارات "أبو الشعوب" محل المركزية الديمقراطية. وفي "الغرب" حيث تهيمن الديمقراطية البرجوازية، وفّرت الظروف المختلفة مساحة أكبر للإبداع الفكري، فأنتجت غرامشي ومارشيه وبرلينغوير وكاريو واليسار الأوربي واليسار الوردي في أمريكا اللاتينية، وأعادت الحياة لفكرة التنوع في إطار الوحدة، تمهيداً لبناء هيمنةِ أيديولوجيةِ يسارية، في مواجهة الهيمنة الأيديولوجية البرجوازية، تُفضي للتحرر من الرأسمالية.
وحين تحققت الثورة الصناعية الرابعة وشهدنا تطوراً هائلاً في التقنية، توزع اليسار بين من بقّي محافظاً حتى على نصوص اغتربت عن السائد، وبين من رأى في التجديد الفعال على ضوء الواقع، ضرورة وجودية، ليس على صعيد بنائه الداخلي فحسب، بل وفي كل مفاصل عمله، ودعا لاعتماد الفكرة والتنظيم والممارسة، القادرة على التكيّف مع الظروف الملموسة لكل زمان ومكان وما وصلت اليه التكنولوجيا من تقدم.
كما حذر هذا اليسار من الخشية من نقد الذات أو تضرر الكواحل عند الاستداريات، ورأى بأن أي تجديد يتبناه، لا يبقى يبعث على الفخر بالضرورة، الاّ إذا تمت مراجعته واختباره بشكل دوري، والإسراع بتغييره كلياً أو جزئياً على ضوء التطورات وما تنتجه من تقدم أو تخلف في الوعي، لأن إغفال المراجعات قد يجعل متلّقي خطاب اليسار أشبه بجمهور صيني يستمع لإحدى روائع الجواهري.
وساعد هذا التوجه أطيافاً من اليسار على تكوين حركات منظّمة في صفوف أجيال جديدة، غالباً ما نفرت من الالتزام السياسي والمركزية المفرطة وعبادة الفرد وتقييد روح المبادرة، محققاً منجزات مهمة على صعيد الحراكات الشعبية أو الانتخابات المحلية والبرلمانية، وعلى صعيد تعبئة آلاف الشباب ممن لا يعرفون رفاقهم أو قيادتهم، ولا تلزمهم أي قيود سوى المبادئ الأساسية التي جذبتهم حين عبّرت عن مصالحهم.
وكما وفّر الواقع التقني المختلف جهوداً كبيرة لتنظيم هذه الأعداد وتربيتهم بضرورة بناء التنظيم السياسي المقترن بأرقى ديموقراطية تتيحها التكنولوجيا، وخلقَ مشاركة جماعية في تطوير الفكرة والأهداف، وفي تنفيذ وتقييم خطط العمل، أثمر عن تنمية الوعي بأهمية بناء أغلبية اجتماعية مناهضة للرأسمالية وتعيق إنتاج استبداد جديد.