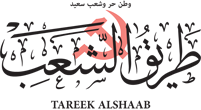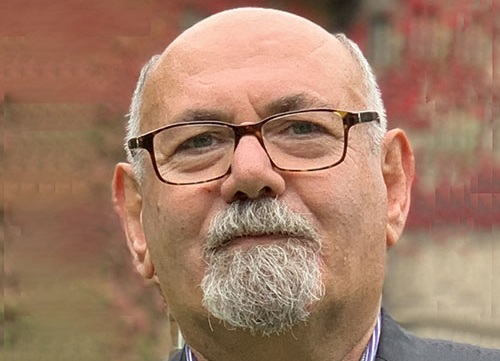إذا كان الوعي الطبقي، كما قال جورج لوكاش، لا ينشأ تلقائيًا من الوجود الطبقي، بل من النضال السياسي الواعي، فإن مقولة ماركس في أطروحاته حول فيورباخ، من أن الواقع لا يتغير بتفسيره فقط، بل بفعل الناس أنفسهم، قد حدّدت بدقة أهمية العامل الذاتي؛ إذ لا يمكن أن تتقد الشعلة، مهما تراكم من حولها الحطب، دون أن تُلهبها يدٌ ثورية.
ربما كان هذا الأمر وراء المكانة المتميّزة التي حظي بها البناء التنظيمي، بين قضايا عديدة اهتمت بتطويرها وتجديدها أطياف اليسار، لا لأنه لقي انتقادات محقة وظالمة فحسب، بل لأن ثمار النصر لن تنضج ببساطة، إلا بتلاقح فاعل بين الظروف الموضوعية والعامل الذاتي، الذي اشتدّت أهميته مع انسداد الأفق الديمقراطي في الكثير من دول الأطراف، وتفكك بنيتها الطبقية التقليدية، وسطوة الأمن والريع والهويات الفرعية فيها.
ورغم أن الأنظمة الداخلية للأحزاب اليسارية لم تكن يومًا مسألة تقنية أو إدارية، بل كانت تعبيرًا عن الرؤية الفكرية للعلاقة بين النظرية والممارسة، بين الحزب والطبقة، فإن التطورات الاجتماعية والتكنولوجية والسياسية في العقود الأخيرة فرضت تدقيق النموذج اللينيني لتلك الأنظمة، وكل النماذج التي استندت إليه، وتحديد ملامح التجديد الممكنة فيه، دون أن يُفقِده جوهره الطبقي.
وكان من أبرز ملامح ذلك التدقيق، قيام أطياف يسارية بتوسيع قاعدتها الاجتماعية، لتشمل إلى جانب البروليتاريا: العمال الزراعيين، وشغيلة الخدمات والتكنولوجيا، والنساء في العمل المنزلي غير مدفوع الأجر، وكل الكتلة الشعبية المتضرّرة من الهيمنة، وتطوير أدواتها بما يكفي لاستيعاب هذه الفئات في الأحياء الشعبية وأماكن العمل والمؤسسات التعليمية والتجمعات النسوية، وتنويع أشكال العضوية، ودعم التنظيم الذاتي للطبقات الشعبية وتشجيعها على بناء السلطة من القاعدة.
كما عمدت أطياف أخرى إلى بناء تنظيمات جديدة أفقية، ذات صلاحيات واسعة وقيادة تشاركية، تجمع بين الشكل الحزبي التقليدي والمنصة الرقمية الحركية، وأطلقت منصات مفتوحة للنقاش الجماعي، خالية من تقديس المُسلّمات والحنين الجارف لماضٍ تليد، وسمحت بتعدّد الرؤى في إطار وحدة الإرادة والعمل، وجدّدت الكادر على قاعدة التجربة العملية والمشاركة في المعارك اليومية ضد الاستبداد والاستغلال والتمييز بكل أشكاله، واستنادًا إلى الجهد الحقيقي الذي يبذله ذلك الكادر في تطوير إمكانياته الفكرية، وأدواته التحليلية، وقدرته على قراءة الواقع الذي ينشط فيه، ومدى مساهماته في العمل النقابي والمهني والدعائي، وفي الحراكات الاحتجاجية.
وبسبب تنوّع مضامين وأشكال تلك التطورات، برزت الحاجة إلى الحوار حول خمسة اشتراطات هامة لذلك التدقيق: أولها أن يكون التجديد في المبادئ التنظيمية متناسبًا مع المستوى الثقافي للناس، ومع المتغيرات التي يشهدها هذا المستوى، وثانيها أن يتزامن مع نجاح اليسار في صيانة جهاز المناعة في صفوفه، وتنشيط هذا الجهاز بشكل دوري، منعًا لتسرّب الخطايا أو تسريبها إلى باحة الدار، وثالثها تحسين المستوى الفكري والسياسي للأعضاء، واعتماد آليات تعالج ضعف الهمم دون أن تمسّ الاستقلالية والمسؤولية الفردية ودمقرطة الحياة الداخلية، ورابعها اعتماد المراجعة الدورية للأشكال الجديدة، بحيث يمكن العودة إلى مفهوم تم التخلي عنه في فترة معينة لأسباب زمانية أو مكانية، إذا ما تطلّبت الممارسة العملية ذلك، وخامسها أن يعكس التجديد التزامًا بالموقف الطبقي؛ إذ لا يسار حقيقي ما لم يتبنَّ الدفاع عن الاشتراكية بوصفها حلًا تاريخيًا، وما لم يربط بين البنية الرأسمالية ومشاكل البطالة والفقر والفساد وخراب البيئة، وما لم يعالج قضايا الهوية والثقافة من منظور علمي، وما لم يصُن الهوية المستقلة لليسار في التحالفات التي يصبح طرفًا فيها.