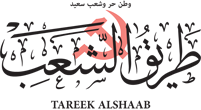عندما اندلعت انتفاضة تشرين، خرج العمال إلى الساحات كما خرج غيرهم من فئات المجتمع، رافعين صوتهم لا من أجل شعارات عامة فحسب، بل وأيضا من أجل مطالب ملموسة، تتعلق بالعدالة الاجتماعية وضمان العيش الكريم. كان حضورهم احتجاجاً صارخاً ضد أزمة البطالة، وتردي الأجور، وغياب الضمانات الصحية والتقاعدية. ومع ذلك، فإن الحكومات المتعاقبة منذ ذلك الحين، تعاملت مع هذه المطالب وكأنها أصوات هامشية، غير جديرة بالاهتمام.
فرغم ما تحدثت عنه البيانات الرسمية الصادرة بعد تشرين، من "الاستجابة لمطالب المتظاهرين"، فإن ما تحقق على أرض الواقع ظل بعيدا عن جوهر ما نادى به العمال. الوعود بتوسيع شبكة الضمان الاجتماعي بقيت حبرا على ورق، والحديث عن تحسين شروط العمل ظل في حدود لجان ودراسات لم يرَ منها العامل أي أثر. بل إن بعض القوانين التي أُقرت، جاءت محملة بالثغرات، كي تسمح لأصحاب رؤوس الأموال بالتهرب من التزاماتهم، تاركة العمال وحدهم في مواجهة ظروف قاسية.
هذا التهميش لم يكن صدفة، بل جاء جزءا من نهج سياسي، اعتاد أن يضع مصالح الكتل النافذة فوق مصلحة الفئات المنتجة. ففي الوقت الذي تنشغل فيه الحكومات بتقاسم المناصب، يترك العامل الذي هتف في ساحات تشرين "نريد وطن" ليواجه مصيرا غامضا: لا ضمان لوظيفته، ولا حماية لحقوقه، ولا صوت حقيقي يمثله في مؤسسات القرار.
الأدهى أن بعض المسؤولين حاولوا تصوير المطالب العمالية على أنها ثانوية مقارنة بـ "المطالب الكبرى" المتعلقة بالإصلاح السياسي. لكن الحقيقة أن أي إصلاح سياسي لا يمكن أن يكتمل من دون عدالة اجتماعية، وأي حديث عن دولة عادلة لا معنى له إذا بقيت الطبقة العاملة خارج حسابات العدالة والتنمية.
اليوم، وبعد مرور سنوات على تشرين، تبدو مطالب العمال وكأنها طُمست عمدا في زحمة الصراعات السياسية. لكن الذاكرة الجمعية لا تنسى. فالعمال الذين حملوا رايتهم في تشرين لم يطالبوا بالمستحيل، بل بأبسط حقوق المواطنة: عمل كريم، ضمان اجتماعي، وأجر عادل. وإذا لم تلتفت الحكومات إلى هذه المطالب، فإن شرارة الغضب قد تعود في أية لحظة، لأن الظلم حين يتراكم لا يقضي على المظلوم، بل يتحول إلى طاقة كامنة فيه بانتظار لحظة الانفجار.