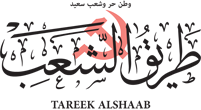رصدت ميسلون هادي منذ روايتها الأولى متغيرات المجتمع العراقي "مجتمع المدينة "بعد تجارب الحروب وأثرها على وعي الإنسان ورؤيته للعالم، و انتجت هذه الحروب صورا مختلفة من" الأوهام" ولكنها لم تكن هي الفيصل في تجربة الحياة إنما هي واحدة من مفاصلها التي لم تمنع سعي الكائن للبحث عن كينونته و هويته "خاصته". وقد تنبهت الروائية لهذه الرؤية وتبنتها في أدبها، لأن الفن يداوي جراح العبث و"يقيّم صلتنا بهذا الوجود ولو كان بالوهم" الذي يخلق "سرده" و هويته في إطار لعبة الزمن بين الانقضاء والحضور، فالقصة مروية زمانية ، وفيها يفعّل السرد الوساطة بين الزمن كانتهاء و"كدوام وبقاء" وهنا تظهر "الرؤية الأيديولوجية" للعالم كما في رواية "سعيدة هانم: ويوم غدٍ من السنة الماضية" فزمن الحدث الروائي كلّه في الماضي في محاولة لإدراك نتائجه وحضوره في الحاضر، لأنه هو الذي شكّل شخصية سعيدة هانم ، و هويتها الملتبسة عن طريق "الخديعة أو الحيلة الشعرية" التي تعد

"مركزية" للحدث؛ وقد وضعتنا الروائية مباشرة منذ " الاستهلال " في ذروة "المأساة" بصورة الشقيقتين سعيدة / مليكة ، وهن يعشن في منزلهن "الكئيب" بمعزل عن الآخرين في عالمهن "المتوهم" و قد توزع المنظور السردي على الشخصيتين لبيان صوت كلّ منهما ورؤيتها في الأخرى و للحياة، لهذا نجد في الصفحة الواحدة تحوّلا في الضمائر مرة بضمير المتكلم في صوت سعيدة هانم وحكايتها عن نفسها وأختها ، ومرة أخرى بضمير الغائب بروايتها عن ذاتها ، وما تشعر به من قلق وخوف من المستقبل و عن " شقيقتها " " المتوهمة " مليكة جان وعلى هذا النحو نفسه ، تقوم مليكة برواية تجربتها مع حضور الراوي الضمني . تقول سعيدة هانم :" مليكة جان عندما تقرر ان ترسم بطين الحديقة .... فهذا يعني أنها متوترة " لترد مليكة جان : " – هل جرِّبت هذا النوع من الحزن ، يا سعيدة هانم ؟ عندما تكونين في قمة السعادة فتلسعك نوبة حزن شديدة، وتقررين اعتزال العالم" لكأن الراوية تريد أن تبين كيف يجري حديثهما ونسقه " المضطرب " وفي هذا التوزيع بانت صفات الشخصيتين على الرغم من سيادة رؤية سعيدة هانم ، وهذا التقسيم يكشف عن "وعي" سعيدة هانم و"لا وعيها" متمثلا في مليكة جان في الوقت نفسه ، مع أن الراوية سعت إلى بيان الخلل ، والاضطراب في سلوك واحدة منهن "الفصام" " إن الخطاب الثنائي الصوت هو دائما ذو صيغة حوار داخلي " وهو يبين " مفهومين للعالم وحوار لغتين " وهذا ما استطاعت الروائية من ضبطه بدقة شديدة لتشكيل بنية " الوهم " بقصد اظهار التوقعات للآتي من الزمن و بدت كلّ شخصية "مرآة " للأخرى ، وعلى وفق هذه الصيرورة المخاتلة ، نكتشف أن الراوي الذي بدا لنا من الرواة الثقة هو غير ذلك ولاسيما أن هناك " مرضا نفسيا " تعاني منه أحداهن ، ففي البداية يصار إلى عدّ " مليكة جان " هي المريضة ، ولكن ما أن ينقشع " الوهم " حتى تتكشف الخديعة فتظهر سعيدة هانم وهي التي تعاني " الفصام " وأما مليكة جان فهي "وهمها" الذي اختلقته في مواجهتها للعالم ، ولذاتها المستلبة ، و قد مثلت "وجهة النظر التعبيرية " جزءا مهما في " الوهم " كما و كانت "وجهة النظر التقويمية " للشخصيتين تعرية لهما ، وفي وجهتي النظر كان الكشف لأصول العائلة الطبقية ، ورؤيتها للواقع عبر اللغة ، بمعنى أن هذه اللغة " طبقية " تحمل في طياتها " رمزا" عائليا يتعلق بالهوية الاجتماعية والثقافية ، فهذه العائلة – يمكن أن تعد - من بقايا طبقة اجتماعية سادت سلطتها و زالت " هانم وبيك وجان " وهذا الاستخدام هو محاولة للتشبث بالموقع اللفظي ، والايديولوجي الذي كان سائدا في الماضي ، والالقاب إنما هي راسب ثقافي – لفظي من رواسب ذلك الماضي السياسي -الاجتماعي ، وعلى هذا يمكن أن تكون الهزيمة الاجتماعية والسياسية أحد أسباب الفصام وعلّته ، وهو الذي خلق " التوهم " ومن أبرز العلامات السيميائية انسحاب الرجل من الحدث " سليمان بيك " فهو دال على هزيمة سلطة طبقتهما ، ولهذا ظل الرجل طيفا باهتا ، ومهزوما ومعوزا ، ولكنه كان يمثل تهديدا لشقيقته لحاجته في غربته ، وعليه كانت شخصية سعيدة هانم مستلبة بين ثقافتين ، و واقعين بما يمثلانه من مأساة ضياع الهوية يقول تودوروف : "إن الجزء الضمني ليس أكثر من أفق العناصر الزمنية – المكانية والدلالية والقيمية المألوف لكلا المتحاورين " وهنا بدت كينونتها / سعيدة هانم / مضطربة تعيش هواجس الاغتراب، فالعلة " الكامنة وراء إشكالية البطل الروائي هي لحظة انفصام الأفكار عن العالم ، وتحوّلها – داخل الإنسان – إلى أحداث نفسية أي إلى مثل عليا عندئذ تفقد الفردية طابعها العضوي .." و من جانب آخر بدت مليكة جان - وهي "لا وعي " سعيدة هانم " - الوحيدة التي تدرك حقيقة الواقع أكثر من" وعي " سعيدة هانم نفسها ، وأظهرت قيمة اللعبة الشعرية في تمثيل عالم الحدث في إشكالياته ، ومآسيه التي أصابت لوثته الجميع . ولهذا تستمر الروائية في لعبتها الشعرية في أن سعيدة هانم كانت تمثل الوعي الطبيعي بالواقع الآني الذي انعكس على " همها " إذ ( إن القلق يهدم ما يبينه الهُم من ضلالات لإغراق الدزاين في طمأنينة كاذبة ، وهو يهز وجود الأشياء " فكأن اتهام مليكة جان "حيلة " ومواجهة دفاعية لسعيدة هانم عن ذاتها ليبرز قلقها وخوفها ، وهي تعيش فوضى الصور ، وفوضى الكلمات بعد انقضاء الماضي بخلاف شقيقتها " مليكة " فسعيدة هانم تفترض في مرات عودة الماضي، فيظهر طيف الأب في زمنها الآني وتوهمها، وهو المعتدي "الجنسي" أو يمثل "السلطة -القوة" المسكوت عنها، وتظهر والدتها في الاسترجاع " البعيد " و هذا الافتراض هو الذي خلق القناع الذي تتقنع به الذات للدفاع عن نفسها من خلال انفصامها عن الواقع ، "سعيدة هانم" تعيد إنتاج العالم عن طريق اللغة والتخييل الشعري ، أما مليكة فأنها تعيد العالم بحسب رؤيتها الإبداعية من خلال اللوحة " اللا المعنى " أو "المعنى المتعدد " أو المعنى الإشكالي / المضطرب في لوحاتها "السريالية " الذي تمثل عالما بلا ضوابط يشبه إلى حد كبير الواقع الآني ، لهذا كان تمثيل الواقع في اللوحات هو الأدق ، لأن الفن السريالي يصور " اللاوعي " أو عالم " التوهم "الصانع للشخصيتين بثنائية إشكالية، فالسريالية تسعى من خلال العقل إلى "توحيد القوى والتأليف فيما بينها " والفن فيها لعبة " الحلم والتداعي الحر وصورهما " مما يؤدي إلى انتاج معان متعددة ، وعليه ظلت مليكة جان في لوحاتها تظن أن مشكلة الدنيا هي أنها خالية من "المعنى" وهذا يعني ان "التناوب- المناولة" بين الضمائر الثلاث ضرورة لسيرورة السرد واكتماله وهنا ظهرت قيمة " المسافة " لبيان اختلاف وجهة النظر التقويمية فكلما جرى تغيير المسافة المكانية ، صاحبها تغيير وجهة نظر سعيدة هانم من لوحات مليكة جان ، كما في وصف فوكو لوحة " فلاسكز " ( مرافقات ولي العهد ) فمع كل تغيير في المسافة تتغير المعاني ووجهات النظر، تقول سعيدة هانم : ( غياب المعنى ... ما ترمي إليه مليكة جان في النهاية ) وسعيدة هنا تحدث نفسها "تيار وعي" لكأن "المرض " كان جزءا من صيرورة الإنسان الذي يتصف بانه " المتجاوز" أو " المتعالي "وهذا التعالي" يحدّد كنهه الكائن الذي يقوِّم كينونته، و من ثم يتبدى فيه " اللبس أو الخديعة " التي كانت من مقاصد السرد الذي يناظر ما جاء في رواية " منزل الكآبة " لديكنز، وفيها تستخدم الراوية (صوتا ساذجا خدَّاعا لتخلق الراوي الإضافي) يستخدم القناع الذي يبدو ساذجا " وناقدا لذاته " فراوية ديكنز تبيّن "عوالم المرضى النفسي التي لا حدود لها، لأنها تعيش عالم التوهم أو " العُصاب "وشخصية إسترا" تتمتع ببلاغة ماكرة " ودهاء لتكسب "التعاطف" وهذا – قريب من "بلاغة" سعيدة هانم "الماكرة"، وهي تحمل حبا لشقيقتها / ذاتها / لتثير من خلاله التعاطف ولكن في النهاية تتكشف حقيقة سعيدة هانم التي خلقت وهمها، وسردها لأنها كانت تعيش صراعا بين الواقع وذاتها في لوحاتها التي تشبه واقع البلد، فقد تعرض عالمها إلى التهديد ، والإمحاء لكأنّ طيات الحدث تفضي إلى تشكيل عوالم متعددة من خلال توهماتها التي تقلقها من الوجود الذي كشف أسئلتها ، و صراعها الدرامي (أنا لست مليكة جان، أنا سعيدة هانم) فكانت مهارة الراوية شعريا هي التي أثارت تعاطفنا معها ، ولاسيما في انتظارنا لزواج/ مليكة جان/ سعيدة هانم/ من شمس الدين وهنا تظهر مفارقة شعرية، يتمّ بطريقة تقوم على كسر توقع المتلقي، فاللعبة لا تنتهي، بل تستمر بعد قرار سعيدة هانم الانتقال إلى دار عمتها حورية/ التي تمثل " العالم البارودي والمحاكاة الساخرة " بحسب باختين / فهي باقية في بلدها، ليبقى الزواج مشروعا مؤجلا و لاسيما أن سعيدة هانم كانت لها رغبة في الرجل / ربما مسكوت عنها / من خلال مليكة ، و تشعر بالحرمان من وصاله فكانت علاقتها مع الزبال ملتبسة ومع السائق جارهم وأخيرا مع الشاب فهد ، وهذه الرغبة ظهرت مبكرة في حياتها منذ " أوهام " تقبيل والدها للفلاحة الصغيرة ، فهذا الوهم بات " ضروري لإخفاء الفراغ في داخلنا " ولكن ثمة عوائق اجتماعية واخلاقية تقف من دون تحقيقه ، وهنا نقول إن الروائية استطلعت أو كشفت قدرات الذات على التلاعب والمراوغة والحيلة الشعرية عبر " التوهم " لتشكيل كلّ هذه الأفكار في إطار الشبكة المفهومية للفعل الإنساني المبهر.