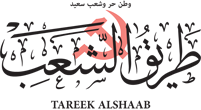كلما ضعفت الدولة السياسية/ المدنية صعد نجم الدولة الأمنية والدولة الدينية، وما عاد الحديث عن الدولة المدنية واضحا سوى ما يكتبه "المثقفون" والدستوريون عن الشأن العام وعن رثاثة الطبقات، وعن السلطة التي تجعل فكرة الدولة مُهدَدة.
ضعف الدولة لا يعني وضعها في الحياد، ولا يعني وضع الأمة تحت تفسير فهم جامح، بل يعني وضعها في التاريخ، بوصفها "ظاهرة" قابلة للنمو والحراك والتعثر والصراع، وقابلة للتحدي، بما فيها تحديات العنف والصراع الداخلي والتدخل الخارجي، لا سيما وأن الدولة العراقية من تأسيسها الملكي حملت معها بذور ازمتها، على مستوى التمثيل السياسي والتركيب الطائفي، وعلى وضع "جماعاتها" امام إشكالية التناشز، وجعل الفرد امام خيارين اوحشهما الاطمئنان الزائف، حيث لا شيء بعد ذلك سوى "الوجود الرث" والتمثيل المصطنع ل"الجماعات المتخيلة" ما يميّز حالة "الدولة العراقية" هو بنية التشظي التي تحكمها، والتي تتبدى من خلال تشظيات ثانوية، على المستوى الطائفي والمناطقي، وعلى نحوٍ يهدد مركزية الدولة "الاتحادية" كمفهوم وكنسق للحكم، حيث تبرز حالة السلطة بوصفها مجالا للتخادم الاجتماعي والسياسي والطائفي، تتحول فيه "الحكومات الناشئة" الى قوى طارئة، تمارس قوتها عبر المال والعنف وسوء الإدارة وغياب البرنامج الوطني، وبهذا فإن الحلول والمعالجات ستبدو محدودة، من خلال تدوير المشاكل، وتكريس ثقافة الجماعة والطائفة، وهذا ما يجعل تمثيلها محفوفا بأخطار جمة، ابرزها القبول بالتمثيل المتعالي لجماعة على حساب أخرى، وربط مفهوم الحاكمية بالهيمنة المكوناتية وليس بخيارات الاجتماع العادل، أو بالمواطنة ال دستورية في مفهومنا المعاصر، وصولا الى الدخول في أوهام نظام "اللانهائية" كما سماه الشاعر عقل العويط.
في هذا النظام ستبدو الأشياء مضببة، والمعرفة بعيدة عن الاستعمال، لأن التشيؤ سيكون هو المركز الذي سيضعها داخل المعيار والقياس، وعلى نحوٍ يجعلها محكومة بعوامل الزوال وليس المكوث، وبالطرد وليس البقاء، وهي ثنائيات تفرض شروطها على يافطة السياسة والعصاب والقوة والطاعة، فالكائن المطيع والمتماثل هو "المواطن المثالي" والنافر والمختلف هو اللامواطن، أو هو الخائن والمارق والزنديق والكافر. لا توصيف ثقافي نقدي لهذه الدولة، ولا سياق لوضع مفهومها قيد التداول، حيث تتحول المشافهة الى قوة للحضور، والى خطاب يؤكد الحكم المتخيل لذلك النظام، ولما يمثله من مركزية، أو من علاقات ضاغطة، ومن هوية أو سلطة، لا مؤسسات لها سوى مؤسسة القوة، واجتماع "الجماعة المتخيلة" تلك التي تملك شرعنة الخطاب والثروة والسلطة، وباتجاه تتحول فيه الأفكار الى أدوات، والمعرفة الى جهاز للسيطرة، والتعليم الى بيت للأشباح، والسياسة الى لعبة مفتوحة على احتمالات متعددة، لكنها غير صالحة للاستعمال خارج أفق تلك السلطة. علاقة الدولة بالخيارات تظل مشوشة، ومنها العلاقة بالديموقراطية، إذ تتطلب هذه الديمقراطية وجود الاجتماع الفاعل، ووجود السياق الذي ينظم التنوع، ويقبل بالاختلاف، وهذا ما يثير أسئلة فارقة، فهو تقاطع مع الواقع، ومع السائد الأيديولوجي والجماعوي والشعبوي، لا سيما وأن هناك جماعات مازالت تنظر الى "الدولة" من منظار التاريخ والفقه وليس من منظار القانون والحق والعدالة والسيادة. السؤال الذي يمكن أن يكون صدمة يرتبط بنقد مشروع الدولة، وبمساءلة المفاهيم التي تتحكم بها، وحتى بمراجعة مراحل ازماتها منذ عام 1921 و1958 و 1963 و1968 و1979 و1980 وما بعدها، حيث تحولت الدولة الى جهاز مغلق للعنف السياسي والايديولوجي، وللاستبداد الذي انكسر عبر الاحتلال الأميركي عام 2003. مراجعة هذه "الزمانات" هو الشرط الموضوعي للتعرّف على هشاشة النظام الذي صنعه، ورثاثة الاجتماع الذي تكرّس معها، وكلا المكونين ظلا بعيدين عن الدرس والقراءة والفحص، لا سيما وأن التضخم السياقي للدولة الجديدة تحول الى ظاهرة معقدة، استغرقها التمثيل الطائفي، والصراع من اجله، وكذلك الفساد والفشل الذي تغذى عن طريق الاقتصاد الريعي، وعن طريق الجماعات التي تجاوزت المفهوم الحقوقي للدولة لصالح تكريس سلطة الجماعة والمال والقوة.
الإرهاب السلفي والجماعوي ليس بعيدا عن فشل الدولة، ولا عن رثاثة هويتها الثقافية، ولا عن علاقة سياساتها في مواجهة العنف الداخلي، والفساد السياسي والاقتصادي، وغياب المشروع الوطني الجامع، ولا حسن إدارة ملفات الثقافة والامن الثقافي والتنمية المستدامة والسيادة السياسية إقليميا ودوليا، فهذه الملفات ستظل مفتوحة مع كل حكومة جديدة، مع كل تحول سياسي جديد..