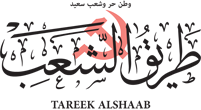إذا كان((التّفكير الصّحيح هو من خلال تحطيم القوالب)) كما عرّفه جلالُ الدّين الروميّ، فما بالُنا بالتّفكير المبدع الخلّاق إذاً؟ إنّ مفهوم التقليد ينطوي على أمرين: الأصل، ومحاكاته. في هذا السّياق نفهم أنّ كلّ شيء ينهض على محاكاة الأصل ما هو إلّا تقليدٌ له، أما الأصل فلا يظلّ محتفظاً بوجوده إلّا من خلال هذه المُحاكاة. وعلى هذا يكون ((ليس من الضّروريّ أبداً أن يُخضِع الشاعر قصيدته لنظام معيّن من الأشكال التقليديّة)) وفقاً لشيلي (1792- 1822م). كما إنّ الاِساءة المتواصلة إلى أدب وتفكيرٍ مختلفينِ من شأنها تدعيم هذا المُخْتـلَف معه، وترسيخهُ عِبر ترويجها له، وفي الوقت نفسه يخلع المُسيئونَ على أنفسهم عن درايةٍ أو دونها صفةَ المُقلِّدينَ، ويُرسِّخون هذه الصّفة بتواصل هذا الخَلْع والاِساءة. أحياناً أقوم بإعادة قراءة نماذج من الشّعر غيرِ المُختَلَفِ عليه عندما لا أطيق تحمّلَ عزلةِ ما أُفكِّر فيه وأكتبُه وما أنتخِب من كتب تتلاءم وطبيعة تفكيري ونهجي. ربّما مردُّ ذلك إلى أنني أحياناً أحاول التّمتُّعَ بشيء من الاسترخاء والاستجمام الذي لا توفّره لي النّماذجُ العابرة للدّارج الشعريّ بخاصّةٍ والأدبيِّ بعامّةٍ، التّمتُّعَ - وإنِ ادِّعاءً- بأنّي سويٌّ غيرُ مُنعزل، أو معزول!
لم أكن يوماً ميّالاً إلى الحماسة وشِعرها ذلك أنّها لا تقوم إلّا على الانفعال الذي دائماً ما تكون الآنيّةُ والمُباشَرة والحِسيّةُ محرّكاتٍ لها على حساب التّفكير والتأمّل وكبْتِهما. استنهاضُ العواطف يعني مزيداً من تنحية العقل المُتفكِّر/ والشّعرُ العربيّ في معظم قديمه ومعاصرهِ زاخرٌ بمثل هذه النّماذج. الحماسة تُكمِّلها الفكاهةُ ذلك أنّ الأولى تحريضيّة تنمِّي الروح الشّجاعة وتدفعها إلى سطح الذّات، أمّا الثانية فامتصاصيّةٌ يكمن دورها في التّخفيف من نتائج الكوارث والآلام والخراب التي تُسبِّبها سياسة الحماسة وآدابُها. نوع من اللعب لإيذاء الانسان ومن ثم تطبيبه وتضميده ليستمرّ اللعب! الفكاهة هنا مربّية وخازِنَةٌ للغضب، ومديرةٌ خفيّة لأعماله إذ إنّها تُقدَّم للمُتَحمِّس الغاضب كوجبة مهدّئة إلى حينٍ ليتواصل اللعب. وعلى ذلك يصحّ قولُ فولتير ((إنّ وحشاً مرِحاً لهو أفضل من آخرَ عاطفيّ مُمِلّ)) ليواصل صُنّاعُ الحماسات اللعبَ بمصائر الانسان والعالم والأشياء. ما دفعني إلى هذه المعالجة بعد أن كنت بعيداً لأكثر من ثلاثة عقود عن ما يُذكّرني بها هو اسهامي مؤخّراً في ملتقىً شعريّ أقامته إحدى الجامعات في الموصل، تمثّلتْ فيه الطائفيّة الفنيّة والثقافيّةُ أوضحَ تمثيل. كانت الحفاوة بقصيدة الشّطرين طاغيةً وهذا لا يعني طبعاً إلى أنّ الزّمن الثقافيّ عندنا لا يزال يسيرُ سَيْرَ القهقرى، وأنّ عقلَ ثمانينياتِ القرن الماضي الشعريَّ والثقافيَّ - وفقاً لطبيعة هذا الملتقى- متقدّمان على عقل اليوم كثيراً. ما قُرِئ كان نظماً ظهيرُه الحماسة وتوسُّلُ حسّ المتلقّي وانفعالاتهِ الآنيّة لا ثقافته وتأمّله، كان شعراً احتفاليّاً لا أكثر.
قصيدة الشّطرين على اختلاف قيمتها الفنيّة سواء كانت ضعيفة، متوسطة، جيدةً مُعترَفٌ بها بعامّةٍ على أنّها شعر لا لشيء إلّا لأنها تتوفّر على ناظم الوزن، أي محتمية بقانون العروض. أما قصيدة النّثر فلا يمكن أن تكون ضمن تدرّجات الضّعف والوسطيّة والجودة تلك، إذ إمّا أن تكون قصيدة شعريّة رفيعةَ المستوى أو لا تكون، كونها مُتَّرِسَةً بثقافة شاعرها الفنيّة والفكريّة والفلسفيّة حسب، ذلك أنّ الشّكل في قصيدة النثر غير مفروض عليها إذ إنّه مرهونٌ بمضمون كلّ قصيدة وطبيعتها. ولكن ((طالما هناك أسلوب، هناك نظمٌ)) كما يشترط مالارميه، مما يعني أنّ النّظم داخلٌ في قصيدة النّثر أيضاً، هذا صحيحٌ لكنْ ما يُميّز هذا النّظم هنا عن نظم قصيدة الوزن أنّه ليس مفروضاً على الشّاعر والقصيدة بوصفه قانوناً يحكمه ناظمُ العروض، لأنّ قصيدة النّثر((شعرٌ من دون نظمٍ خارجيّ)) كما عرّفها تودوروف. وعلى ذلك إن لم تكن هذه القصيدة ثريّةً جماليّاً ومعرفيّاً لا قيمة مهمّةً لها كونها ليست محميّة بقواعد النّظم كالوزن والقافية، تلك القواعد الوسادةُ التي تتّكئ عليها القصيدة القديمة.
قصيدة النثر تتطلّب من شاعرها أن يتمتّع بثقافة واسعة عميقةٍ، ووعي نفّاذ، وحساسيّة حادّةٍ، أن يكون مُقَلِّبَ نَظَر في الأشياء من طراز فريدٍ لأنّها ((سحر ملتهبٌ صافٍ))، و((فِكر محمومٌ)) كما وصفها سانت بوف، ونرفال. أهمّ امتياز لقصيدة النثر عن سواها أنّها توفّر لشاعرها أن يكتب ((الأكثرَ من خلال الأقلّ)) لما تتميّز به من شدّة العمق والتّكثيف.
لا يمكن لأيّ نصّ أدبيّ مهما كان حرّاً أن يتمتّع بالحرية كاملةً كونه يظلّ بنسبة أو بأخرى مشروطاً بسلطة النّوع (الجنس) الذي كُتب به حتّى لو كان مُهَجَّناً. قصيدة النثر نفسُها التي هي وليدة مصاهرة جنسينِ مختلفين نوعيّاً تظلّ مشروطة بآليّتيهما. رأى كوهين بما معناهُ أنّ الاِيحائيّة والمطابقة يمكن من خلالهما فرز ما هو شعريّ عن الآخر النثريّ، فالشّعر انزياح وايحاء عبر المجاز أمّا النّثر فاستقامةٌ ومطابقة كونه لا مجازيّاً.
هذا هو المفهوم المركزيّ الذي كان شائعاً قبل أن تتمكّن قصيدة النّثر الحقيقيّة من ((التّعبير شعريّاً بالنّثر)). باختصارٍ الشّعر ليس نقيضاً للنّثر، بل نقيضٌ لِلا شِعر. أَخلصُ إلى أننا هنا أمام سلطتين تواجهان حرية الكتابة: سلطة الفكرة، وسلطة النّوع.
إنّ طائفيّة قصيدة الوزن مُتأتّيةٌ من كونها بدويّةَ المَنشأ والتّربية والتّفكير والنّزعة، ومن هنا تأتي مُناصبتُها العداءَ لمدينيَّة قصيدة النثر، بمعنى أنّها ليست معركة أشكال وأساليبَ تعبيرٍ، هذا هو الظّاهر، وإنّما هو صراع بين عقليتين فكريتين متناقضتين تماماً. الحداثة مرتبطة دائماً بالعقل المدينيّ ارتباطاً نسيجيّاً وذلك ما جعل من قصيدة النّثر لازبةَ الوجود كونها الأكثرَ تعبيراً عن هذا العقل، لما تتّصف به من حسّاسيّة عالية التّوتر حدّة وتشابكاً وتناقضاً وتعقيداً كما الحياة في المدينة قياساً بحياة البداوة والأطرافِ البسيطة والتلقائيّة والحِسيّة. قصيدة النثر هي اللبُّ، الجوهر كونها صافية مُنقّاةً من أيّة وسائل خارجيّة مُساعِدة، إنّها أُزْمازومُ (نُخاعُ) الشّعر. وهكذا كلّما ارتفعت درجةُ عناية التّعبير الشعريّ بالدّلالة فكراً وعمقاً تطلّب حريّة أوسعَ، وما عنايةُ هذا التّعبير بـ: العبارة دون البيت إلّا تحرّرٌ من حدود هذا البيت، وخروجٌ إلى ما هو رحبٌ كما الفرق ما بين: مفهوم الخيمة/ ومفهوم المنزل. وقِسْ على ذلك عندما يوغل التّعبير في الذّهاب إلى ما وراءَ المعنى والمقصود، وإلى جعل العبارة الشعريّة هدفاً فكريّاً وفنيّاً وفلسفيّاً بحدّ ذاته.
لا تزال بساطة التّفكير وتسطيحه سائدةً أكثر من أيّما وقت مضى أمام انعزال العُمق، فالقرّاء الذين تحوّلوا إلى جمهور ومتلقّينَ ومن التحق بهم من الأجيال اللاحقة، إلّا ما ندر، ما عادوا مهتمّين بمن يُعْمِل فيهم القلقَ والتأمّل والتفكّر والتفتّح والتنوّرَ، وإنّما مطلبُهم ما يُسلِّي أو يُحمِّسُ، فلم يعد للشّعر النوعيّ أمام الكميِّ إلّا مساحة ضئيلة لا تزال تنحسرُ على الدّوام، لذا انصرف أغلبُ الشعراء إلى الكتابة الاحتفاليّة الجماهيريّة. فلتكون فريداً لابدّ بداهةً أن تخترق ما هو قارٌّ، نمطيٌّ، سياقيّ، لكنْ في مثل هذا المحيط الثقافيّ الحاليّ فقدت العلامات الأدبيّة الفارقةُ قيمتها وأسبابَ وجودها، وانحسر تعويلُها أكثرَ على القلّة القليلة من القرّاء والنقّاد النّوعيين حتّى أصبحت هذه العلامات أقليّة مُهَمّشةً مِن قِبَل سُوق ثقافة (الدَّايت)، بخاصّةٍ الفيسبوكيّة منها. من حقّ مُتلقِّي هذه الأيام وفقاً لمبادئ الدّيموقراطيّة (السّائدة) أن يفرضوا ذائقتهم لأنّهم أغلبيّة، أعني ذائقة التّرفيه والتّسلية، وما يقع خارج ذلك سيوصَمُ بالتّعالي والأرستقراطيّة. وهذا ربّما وفقاً للتقاليد الدّارجة ما يمنحهم حقَّ أن يكونوا المقياس! الأدب المرموق ليس أمامه اليوم إلّا الانسحاب أو الصّمت كما أيّ عمل كماليّ أو شخصيّ، ما دامت الأغلبيّة هي من تحدّد تداول البضاعةِ وقيمتَها والتّرويجَ لها!