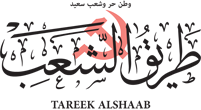حلول مشكلة المياه: جعجعة بلا طحين
حول الإجهاد المائي في دول الشرق الأوسط، ومنها العراق، كتبت نور حمّاد مقالًا للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، ذكرت فيه أن 16 من أصل 25 دولة في المنطقة هي الأكثر معاناة من شُحّ المياه في العالم، مشيرةً إلى أن المياه المشتركة، كموردٍ طبيعيٍّ نادرٍ واستراتيجيٍّ في الوقت ذاته، تكون عرضةً للممارسات الاحتكارية والنزاعات البينية.
النزاع على حصة العراق
وذكر المقال أن حقوق المياه في الأحواض النهرية المشتركة في سوريا والعراق تُعد من أكثر القضايا الخلافية في المنطقة، فكلتا الدولتين تقعان في موقع المصب، ما يجعلهما عرضةً للتغييرات الأحادية في إمدادات المياه من الدول الواقعة عند المنبع، والتي قد تُحوِّل مجرى الأنهار لتلبية احتياجاتها المحلية.
وعلى الرغم من تراجع التوترات بين أنقرة ودمشق بعد سقوط نظام بشار الأسد، وتحسُّن العلاقات بين تركيا والعراق، فإن حلّ النزاعات المائية القديمة لا يزال يتقدّم بوتيرة غير واضحة.
عدم احترام الاتفاقيات
وجاء في المقال أن تركيا وسوريا وقّعتا عام 1987 اتفاقيةً لتقسيم حقوق المياه بينهما، شملت بشكل غير مباشر العراق من خلال معاهدة سورية–عراقية لاحقة أُبرمت عام 1990، إضافةً إلى مذكرة تفاهم في عام 2009 لتعزيز التعاون الفني بين الدول الثلاث المتشاطئة. إلا أن تركيا قامت بتغيير تدفقات الأنهار وبناء السدود بما أضرّ بجيرانها من دول المصب، ضمن مشروع جنوب شرق الأناضول التركي، الذي يهدف إلى توليد الطاقة الكهرومائية وريّ أكثر من مليون هكتار من الأراضي الزراعية في جنوب البلاد، ويضم أكثر من 22 سدًّا على نهري دجلة والفرات، وهما المصدران الرئيسيان للمياه في كلٍّ من سوريا والعراق.
وأضافت الكاتبة أنه نتيجةً لذلك، تراجعت حصة العراق من مياه النهرين بنسبة تتراوح بين 30 و40 في المائة منذ عام 1975، وتفاقمت المشكلة حين قامت إيران بتحويل مجاري المياه من نهر الزاب الصغير (الذي انخفضت مستوياته بنسبة 80 في المائة بسبب سدّ “كولسا” الإيراني) ونهر ديالى، لاستخدامها في الزراعة ومياه الشرب داخل الأراضي الإيرانية.
غياب وحدة القرار
وأكدت الكاتبة على أن الخلافات الداخلية في العراق حالت دون اتخاذ إجراءات حازمة ضد هذا التجاوز على الحقوق، مشيرةً إلى أن وزارة الموارد المائية العراقية كانت مستعدةً عام 2021 لمقاضاة إيران أمام محكمة العدل الدولية بشأن سياساتها المائية، لكن القضية لم تصل إلى المحكمة على الأرجح بسبب النفوذ السياسي والاقتصادي لإيران في البلاد. كما يغيب التنسيق الفعّال بين إقليم كردستان وحكومة بغداد حول بناء السدود والتعاون المائي.
رياح التغيير المحتملة
ورغم التعقيدات، رأت الكاتبة وجود بوادر تغيير إيجابي في الأفق؛ فقد أدّى تقارب العلاقات العراقية–التركية إلى حراكٍ دبلوماسيٍّ نشطٍ حول ملف المياه، أسفر عن توقيع اتفاقٍ إطاريٍّ لتقاسم المياه عام 2024، إلا أن أنقرة لم تنفذ التزاماتها المتعلقة بحصص المياه بالكامل حتى الآن. كما اتفق العراق وسوريا في أغسطس 2025 على تعزيز التعاون المائي من خلال تشكيل فرقٍ فنيةٍ مشتركة لمراقبة مستويات المياه والمؤشرات الهيدرولوجية الأساسية، إلى جانب تنسيق المواقف المشتركة مع تركيا بشأن تقاسم الموارد المائية. غير أن فعالية هذه الإجراءات الجديدة لا تزال غير واضحة.
القانون الدولي وتقاسم الموارد المائية
وذكر المقال أن القانون الدولي ينص على توزيع حقوق المياه في الموارد المشتركة، مثل الأنهار العابرة للحدود، بشكلٍ منصفٍ ومعقولٍ بين الدول. كما ينص اتفاق الأمم المتحدة لعام 1997 بشأن استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية على مبدأَي الاستخدام العادل والمعقول، ويلزم الدول بالتعاون وتجنّب التسبب بضررٍ جسيمٍ للدول الأخرى. غير أن هذا الاتفاق يُعد إطارًا عامًا غير مُلزِم بشكلٍ صارم، ولا تزال العراق الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي انضمت رسميًا إلى الاتفاقية، فيما تتواصل الوعود والحوارات دون أن تصل إلى حلولٍ تتناسب مع سرعة التغييرات المناخية في المنطقة.