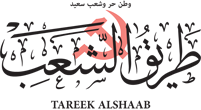لا طريق للمثقف الذي يكتب، أو يفكر عبر الكتابة.. الا الذهاب الى غابة المعرفة، للتعرّف على اسرارها، والتزود من فيض عوالمها، ليس لصناعة المثقف" الحطاب" أو المثقف الذي يشبه روبن هود، بل لكي تكون صناعة المعرفة ممارسة في "حماية الوعي" عبر تغذية الحدوس، وعبر صيانة مفهوم قوة، في التأسيس والتأهيل، وفي صياغة الأسئلة التي تتقصى اسرار الغائب والمحذوف والمخفي، وباتجاه يجعلها اكثر استعدادا للقبول والتفاعل مع ما تصنعه النظريات والمناهج، وما تدعو اليه من سجال وتواصل، ومن أفهام يخص ما هو نظري في تداولية واستعمال مفاهيم تلك المعرفة، وكذلك كل ما يخص ما هو اجرائي، يُعنى بالتحقق العملي في تمثيل الصيغة الأسلوب والربط والتوظيف.. من أكثر المصطلحات اثارة للجدل هو "الخطاب" الذي تصنعه المعرفة، بوصفه مجالها ونتاجها، واداتها في فحص وظائف تلك المعرفة، وفي التعرّف على حيوية توظيفها في مجال الدرس العلمي و"المجال العام" وفي تنشيط فاعليات القراءة، وفي الكشف عن تأثيرها داخل الممارسات الثقافية والكلامية.. كما ان توسيع مساحة الخطاب، يعني الانتقال بالمعرفة الى مستوى علاقتها بحيوية الأفكار، وبفاعلية وظائفها، في الاشهار والنقد والتحليل، وفي المقاربات النظرية والمنهجية، لكن ذلك لا يحدّ الاكتفاء بها، على المستوى الاكاديمي أو النقدي، بل سيكون الأخطر تمثيلا لعلاقتها بالايديولوجيا، وتحول خطابها الى سلطة، لأن هذه السلطة ستذهب الى صناعة منابر ومؤسسات وقوانين، وحتى سجون ومستشفيات ومدارس، وأنظمة للمراقبة والفحص، لتكون تحت هيمنة دوغمائية لتلك السلطة، وعلى نحوٍ يجعلها خاضعة الى سياسات لا حدود لها، فبقدر ما تبدو حمائية فإن مصطلحاتها لن تكون بعيدة عن المكر في التوصيف، وفي التعويم، مثل "الأمن العام" و"الذوق العام" و"الاخلاق الرشيدة" وحتى تداول المفاهيم مثل "الهوية" و"الأمة" و"الدولة" و"الطائفة" وغيرها..
هذا التحول سينزع عن المعرفة كثيرا من قيم وجودها في النسق، وسيخضعها الى سلطة التاريخ، والى "الأعراف الاجتماعية" و"الاحكام السياسية" حيث ستتفرض على التداول مهيمنات خادعة وزائفة، تتخفى عبر اقنعة الخطاب الإعلامي، والخطاب الديني والخطاب الرئاسي، وحتى الخطاب الطائفي وغيرها..
لقد عمد فوكو الى ربط الخطاب بالافكار، وحتى بالتطبيقات التي جعلت منه غامضا، وخاضعا لمرجعيات تلك السلطة اسرارها، وهذا ما جعله بعيدا عن الاستخدامات النقدية، لا سيما الأدبية، إذ يؤشر هذا البعد نوعا من العزل المفهومي، والتأويلي، وما يستدعيه من إمكانات يمكن أن تجعل من الخطاب " واقعا معرفيا" على مستوى الفاعلية النقدية، وعلى مستوى توظيفها كأداة في زعزة المعنى، وفي توسيع مساحة المعرفة ذاته، لا سيما وأن فوكو قام بدراسات واسعة- ليست أدبية- لكن يمكن اعتمادها في النقد الأدبي، والنقد الثقافي كأدوات تخص موضوعات الجنسانية والقمع والمراقبة والسجن، والتي نحتاج التعرّف على مرجعياتها النقدية للتعرّف على الخطاب الذي اقترن بها، في تاريخنا، وفي علاقة هذا التاريخ بالسلطة المستبدة التي ورثناها منذ اكثر من الف سنة..