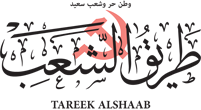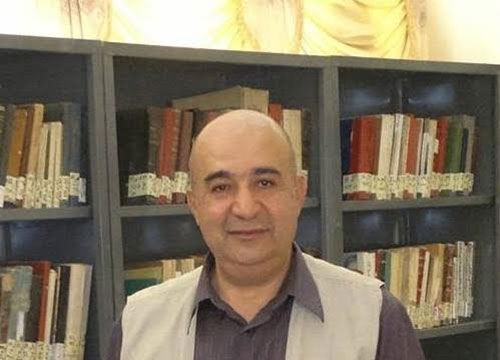الرواية عمل شاق وشائك، وتتمثل كتابتها عن طريق نسق مختار من بين الأنواع المتعددة؛ جميع أحوالها القلب النابض للرواية، النسق الروائي هو الطريقة التي يروي بها الروائي عالمه المتخيل، صنعته المتقنة أو رسالته الى القارئ حتى يقنعه إنها القضية التي يجب ألا تكون مخفيّة، يرسم بدقة شخصيات توضح تشابك الأحداث.
اغلب الأنساق الروائية تختلف من كاتب الى آخر، وليست عملية "نقل للأحداث" بترتيب زمني، بل هي رؤية الكاتب للعالم الذي يصنعه، وكيفية تقديمه بوضوح للقارئ حتى يستفيد منه. فالسرد نظام يجري كنسق بنائي يقوم على نظام يقنعنا فيه الكاتب بأحداث روايته حيث كل تجربة - القناعة التامة بما يقدمه للقارئ، تتنوع وفق نظام جلي له نسق يعبر بواسطة شكل من أشكال السرد. كما في الروايات التي كتبت في السابق باختلاف الأهداف، باستخدام الأساليب الفنية المتاحة. الرواية.. حرية مطلقة للبوح، مساحة عصرية تتسع لمن يحضر العصر ليقول إنني حيّ أُرْزَقْ ولا يمكن أن يسلب حقي في الرأي والتنفس. ومن حق أي كاتب اختيار الموضوعة المناسبة للبوح من خلالها بما يريد أن يبوح به، الرواية دائما يختارها، من تنبض عروقه بالعطاء. انها وسيلة حرة للتعبير ومن حق الجميع محاولة كتابتها، شرط أن يقنع كاتبها القارئ وان لا يستغفله على انه مُسطح، وألا يستهين بفرصته الذهبية الممنوحة من لدن القارئ، وألا يضيّع له وقته الثمين في ترّهات عشوائية قد تقرفهُ، وتجعلهُ يندم مما حدث معه. البعض يجد سبيله في سرد خطي أي يتابع حدثا قد حدث، كالخط المستقيم الذي تسنده المسطرة، وفق ترتيب زمني واضح: بداية، ثم وسط، ثم نهاية. يعرف هذا الشكل بأنه "السرد الكلاسيكي حيث يبدأ الكاتب بتمهيد الشخصيات والزمان والمكان، ثم يتطور الصراع حتى يصل إلى الذروة، وينتهي بنهاية القصة حيث يضع لها نتيجة أو نهاية مفتوحة. ذلك السرد شائع في الروايات التاريخية والواقعية، لأنه يمنح القارئ إحساسا بالوضوح والانسيابية. مثال: روايات: نجيب محفوظ، وديكنز وروايات مثل "زيفاكو"، وروايات "روكامبل" الشهيرة التي تحافظ على التسلسل الزمني الواضح، فالاطلاع على الرواية العالمية تعلم علامتها، وتذكر أن هناك سرد دائري يبدأ من حيث تنتهي في نفس النقطة، تضع دليلا الى القارئ لكي يعود إليها. هذه التقنية تمنح إحساسا بالقدرية أو التكرار الحتمي للأحداث، وغالبا ما تستخدم لإبراز فكرة أن الشخصيات لا تستطيع الهرب من مصيرها. مثال: بعض أعمال "خوسيه سرماغو"، "غابرييل غارسيا ماركيز"، "ماريو مارياس يوسا" حيث تتكرر الأحداث بنكهة أسطورية. تجعلنا نعود الى نقطة البداية، لتكتمل دورة يريدها الكاتب. على عكس تلك الطريقة التي تعتمد التقطيع ، أي إنها تتجاوز السردية المنتظمة وتفلت من القيود الزمنية، فتقفز بين الماضي والحاضر وربما المستقبل. هنا، يختلط الحاضر بالذكريات والاستباقات، في محاولة لخلق تجربة قرائية أكثر تعقيدا وعمقا. هذا النوع يناسب الروايات النفسية أو الفلسفية، حيث يعكس تشتت الوعي أو تعدد وجهات النظر. كرواية "البحث عن الزمن المفقود" لمارسيل بروست، وخريف البطريرك لماركيز عندما تنقل ليروي لنا تاريخ الدكتاتورية الحاكمة في بلاده التي أمسكت بها الرواية وأسقطتها بشكل عنيف ومهيب جعلتنا كقراء نتفاعل مع ما نقرأ. وكذلك هناك من يسرد روايته عبر الأصوات المتعددة، حسبما يرى في تعدد الشخصيات مجالاَ حيويا لان يروى الحدث من أكثر من منظور واحد، بل من خلال عدة شخصيات، لكل منها صوتها ورؤيتها الخاصة.
تلك الطريقة تحتاج الى راو سارد ماهر يجيد القبض على الزمن ليكشف التناقضات من عدة زوايا، بعضهم يجعل القارئ مشاركا في البحث عن الحقيقة وسط تعدد وجهات النظر. كما في أعمال "عبد الرحمن منيف" في "ارض السواد"، و"مدن الملح" كذلك في رواية "الأخوة كرمازوف" لروائي الروسي الشهير "دستويفسكي"، وتعدد الأصوات في "الصخب والعنف" للكاتب الأمريكي "وليام فوكنر" التي تنقل الأحداث من عيون مختلفة، ومن زوايا متعددة.
إضافة إنها تعتمد (ضمير المتكلم) وفي نفس الوقت تساهم في تقديم تواصلي للحدث حيث تجعل القارئ قريبا جدا من مشاعره وأفكاره. هذا الأسلوب يعزز الإحساس بالحميمية، لكنه قد يكون محدودا لأنه يقتصر على ما يعرفه الراوي. كذلك "ذكريات منزل الأموات" لدستويفسكي "الشيخ والبحر" ل"ارنست هيمغواي" ثم "الأمير الصغير" للكاتب "أنطوان دو سانت إكزوبيري"، حيث العالم يرى بعين الراوي فقط، يمكننا أن نناقش في ذلك (الراوي الكلي المعرفة) كما تسميه "جوليا كريستينا" حيث يكون الراوي حاضرا في كل مكان، يعرف كل شيء عن الشخصيات وأفكارها وماضيها ومستقبلها. وحسب "ميخائيل باختين" يمنح هذا النوع من السرد حرية كبيرة في الانتقال بين المشاهد والأزمنة. كما في "الحرب والسلام" لتولستوي و"المقامر" "الجريمة والعقاب" لدوستويفسكي.
لكل كاتب حرية مطلقة في طريقة روي روايته، حرية مفتوحة، لدعم حرية الرأي، والموقف.. تكاد تكون كالماء المبذول لشاربه، وكل له الحق في تجربته السردية بكسر القواعد التقليدية، مثل إدخال نصوص غير مكتملة، أو اللعب بالخط البصري على الصفحة، أو إدماج الشعر والمذكرات والتقارير الصحفية كما فعل "صنع الله إبراهيم" في روايتيه الرائعتين "بيروت.. بيروت" و"وردة". وهذا يناسب الروايات الحداثية.
مسألة تقنية رؤية تؤهل الكاتب للاقتحام، محافظا على هدف يتمثل كيف يرى ذلك الحدث، بشرط الجديّة تتمثل أن يضع القارئ في نظامه الخاص مفترضا الكيفية في تفاعل الشخصيات التي من الممكن أن تبقى حيّة تعيش حرة خارج متن الكتابة.