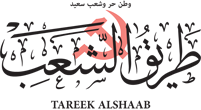منذ أن وجد الإنسان على وجه البسيطة ، ومنذ أن شرع بتكوين الجماعات والمجتمعات ، سواء منها المترحلة / البدوية ، أو المستقرة / الحضرية ، وهو يحاول أن يعطي لوجوده الإنساني قيمة ويضفي على حياته الاجتماعية معنى . ذلك لأن كينونة الإنسان – من دون سائر المخلوقات الأخرى – لا ترتهن فقط بالعناصر الطبيعية (جغرافية وإيكولوجية)، أو ترتبط بالمعطيات المادية (اقتصادية واجتماعية) فحسب ، وإنما هي متعلقة بمجموعة من العوامل الروحية (اعتقادات وديانات) ، والنفسية (دوافع ونوازع) ، والرمزية (إيحاءات ودلالات) وكذلك . لا بل أن هذه الأخيرة تتقدم - من حيث التأثير والأهمية - على ضرورات الأولى وتجبّها في بعض الأحيان والظروف . ولهذا فقد وجد (( ان السلطة الرمزية – كما لاحظ الفيلسوف وعالم الاجتماع الفرنسي (بيار بورديو) – من حيث هي قدرة على تكوين المعطى عن طريق العبارات اللفظية ، ومن حيث هي قدرة على الإبانة والإقناع ، وإقرار رؤية عن العالم أو تحويلها ، ومن ثم على تحويل التأثير في العالم ، وبالتالي تحويل العالم ذاته، قدرة شبه سحرية تمكن من بلوغ ما يعادل ما تمكن منه القوة (الطبيعية أو الاقتصادية) بفضل قدرتها على التعبئة )) . وهو الأمر الذي لم تتوانى مختلف السلطات - قديمها وحديثها - في استثمار دوره واستغلال تأثيره في توجهات أفرادها وتعبئة جماعاتها ، على صعيد تنميط وعيهم ، ونمذجة سلوكهم ، وتأطير علاقاتهم.
والمقصود بالعبارات الواردة في العنوان الرئيسي (الايقونات والرمزيات السيميائية) على وجه التحديد ؟ هو ان (الايقونات) مجموعة (الصور) و(الرسوم) و(النصب) و(التماثيل) وما يدخل في نطاقها ، التي غالبا"ما ترمز الى (شخصية) ما أسطورية متخيلة ، أو تاريخية حقيقة ، أو (موقع) ما أثري شاخص ، أو ديني مقدس ، أو (حدث) سياسي كبير ، أو عمل عسكري مميز .
أما بالنسبة للعبارة الثانية (الرمزيات) فالمراد بها هنا الإشارة الى كل ما يرتبط بكيان (الدولة – السلطة ) ومؤسساتها السيادية؛ الأعلام الوطنية ، واللافتات السياسية ، والعملات الرسمية ، والشارات التكريمية ، والأوسمة العسكرية ، وما يدخل في نطاقها من جهة . وما يتعلق بشخصية (المجتمع) وطبيعة هويته الحضارية ، لجهة تنوع ثقافاته القومية ، وتعدد طوائفه الدينية، وتباين جماعاته القبلية العشائرية من مثل ؛ الأضرحة والمقامات التي ترمز الى شخصيات دينية، والأعلام والرايات التي ترمز الى الخصوصيات القبلية والعشائرية ، والاحتفالات والمهرجانات الثقافية التي ترمز الى الأعياد والمناسبات ، والصور والملصقات التي ترمز الى الشخصيات الاثنية والمذهبية.
ورغم الاختلافات الكبيرة والتباينات الواسعة بين المجتمعات المصنفة (متقدمة)علميا"وصناعيا" وحضاريا"، وبين نظيرها المصنفة (متأخرة) في ذات المجالات والميادين والحقول ، إلاّ أن كليهما لا ينيا يحرصان على الاحتفاء بأهمية ودور (الايقونيات) و(الرمزيات) في حياة شعوبهما ؛ إن من حيث قدرتها السيميائية في إحداث التغييرات المطلوبة والمرغوبة سواء في مضامير السياسة أو قطاعات الاقتصاد ، أو من حيث سعة الانتشار سوسيولوجيا"وعمق التأثير سيكولوجيا". ولهذا فقد أشار الباحث الغربي (ديفيد هوكس) الى أهمية العامل (السيميائي) في التلاعب ببنى الوعي والتحكم بأنماط السلوك ، بحيث لا تستحيل فقط الرموز المجردة الى أشياء واقعية فاعلة ومؤثرة فحسب ، بل ان تأثيرها في الواقع يغدو أشدّ وقعا"وأكثر حضورا". ولهذا فقد كتب يقول (( كلما ابتعد الاقتصاد عن إنتاج الأشياء المادية الواقعية وصار ، بدلا" عن ذلك خاضعا" للتبادل السلعي الذي يتحقق من خلال توسط التمثيل المالي ، جاز لنا أن نتوقع أن تولى الفلسفة قوة مجددة متزايدة لأنظمة الدلالة التي تبلغ حدّ اعتبارها الواقع الوحيد الذي نمكن معرفته )) .
وفي إطار هذه الرؤى والتصورات ، تبدو (الإيقونات) و(الرموز) التي باتت تتوالد وتتناسل على إيقاع التصدعات والانقسامات والصراعات (سلاح ذو حدين) ، ينبغي التعامل معها بحرص شديد وحذر بالغ وإلاّ فإن العواقب الناجمة عن إساءة استخدامها ستكون كارثية ومدمرة ، ليس فقط على صعيد سلطة (الدولة) التي قد لا تحسن التعاطي مع هذه الأشكال والتعابير (السيميائية) ، بحيث يمكن أن يقوّض شرعيتها ويتحدى سلطتها ويهدد وجودها فحسب . وإنما على كيان (المجتمع) الذي ربما يشتط في توظيف دورها واستثمار قدراتها واستخدام إيحاءاتها ، بحيث يفضي به ذلك ليس فقط الى التصادم مع الدولة التي اختارت أن تكون طرفا"في أتون هذا المعترك (السيميائي) الخطر فحسب ، وإنما الانخراط في دوامات تصعيد الاحتقانات وتأجيج الكراهيات وتعميق الانقسامات.
ولغرض معرفة الكيفية التي من خلالها تستحيل هذه الأشكال والتعابير (الرمزية) التي ترتكز فاعليتها ويتمحور تأثيرها على ما تتوفر عليه من قوة (ناعمة)هائلة بإمكانها فعل الأعاجيب ، الى عامل شديد القوة في التأثير سواء في حالات النهوض والتطور أو في حالات النكوص والتقهقر ! . ينبغي أن نشير الى أن تلك الأشكال والتعابير لا تحمل في ذاتها - من حيث الأصل والطبيعة – خصائص معينة يمكن اعتبارها (إيجابية) أو (سلبية) بالمطلق ، وإنما هي – ضمن بئيات اجتماعية وظروف سياسية وسياقات تاريخية – تستحيل ؛ أما الى عامل (بناء) و(تعمير) بإمكانه تقوية كيان (الدولة) وتعزيز هيبتها من جهة ، وجمع شتات المكونات الاجتماعية المتنافرة وسمتنة وحدتها من جهة أخرى . وإما ينقلب الى عامل (هدم) و(تدمير) باستطاعته تحطيم كيان الأولى وتشتيت شمل الثانية بزمن قياسي .
وهكذا ففي (الحالة الأولى) يمكن ملاحظة أهمية الدور وقوة التأثير الذي تمارسه الرموز والإيقونات ، عند تعرض الدولة أو المجتمع الى ما يهدد وجودهما الجغرافي والسياسي بالفناء ، حيث يمكن استثمارها في شحذ الهمم وتقوية العزائم لرفع مستويات التحدي وتصليب روح المقاومة . وذلك بالحضّ على وضع الخلافات والصراعات البينية جانبا"، والتركيز من ثم على ما يدعم سيادة الدولة ويعزز سلطتها من جانب، ويحافظ على وحدة المجتمع ويحمي شخصيته ويصون هويته من جانب ثان ، أي بمعنى استثمار تلك الرموز السيميائية استثمارا"وطنيا" وإنسانيا"وحضاريا". وأما في (الحالة الثانية) فإن هذه الأخيرة ستكون وبالا"على الدولة وشرا"مستطيرا"على المجتمع في حال واستغلال دورها الاجتماعي واستثمار مخزونها النفسي ، عند وقوع الحروب والصراعات (الأهلية) التي تكون الدوافع (القومية - العنصرية) و(الطائفية - المذهبية) و(القبلية - العشائرية) سببا"أساسيا"في اشتعال فتيلها واندلاع سعيرها .
ولعل حالة المجتمع العراقي في الوقت الحاضر تعطينا المثال / الانموذج الأشدّ ضراوة على استغلال واستثمار الرمزيات والايقونات وفقا لتوصيف الحالة (الثانية) ، حيث تنهمك قواه السياسية وتنخرط مكوناته الاجتماعية بحمية لا تحسد عليها في أتون من المنافسات البدائية المزيادات الفجة ، التي تستعرض مختلف (الصور) و(الأعلام) و(الرايات) و(الشارات) و(التشابيه) ، التي لا تخفى دلالاتها (الدينية – الطائفية) و(القبلية – العشائرية) و(الاثنية – العنصرية) بشكل سافر ، لا بل يكاد يكون استعراضا"(استفزازيا") على صعيد جمعي ، بحيث تستنفر كل العصبيات وتجيش كل الأصوليات بما يوحي بأن المجتمع تحوّل من الحالة الحضارية الى الحالة البربرية!