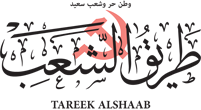لم تكن الماركسية مجرد نزوة فكرية أو محاولة عابرة لإعادة صياغة العلاقات الاجتماعية والاقتصادية، بل مثّلت على امتداد قرن كامل مختبراً هائلاً لمراجعة أعمق البنى التي يقوم عليها الاقتصاد البشري. لقد خرجت الماركسية من رحم نقد الرأسمالية، لكنها لم تبقَ في حدود السجال الفكري، وإنما دخلت الواقع لتشكل مؤسسات وتجارب ودول، وتفرض على العالم بأسره إعادة التفكير في معنى الإنتاج، والعدالة، والقيمة، والتوزيع. وإذا كانت الرأسمالية قد حققت تراكمها التاريخي على حساب استغلال الإنسان وتهميشه، فإن الماركسية، في صورتها التطبيقية، رفعت الإنسان إلى مركز العملية الاقتصادية بوصفه المنتج الأصيل، لا مجرد أداة من أدوات الربح.
المجتمعات التي خاضت التجربة الماركسية لم تكن محظوظة بما يكفي من الثروات الطبيعية أو البنى الجاهزة، وإنما كان رصيدها الأكبر هو قوة العمل الجمعي والإيمان بأن العدالة يمكن أن تكون أساس النمو. لقد أظهرت التجربة، بكل ما لها وما عليها، أن الاقتصادات قادرة على النهوض من تحت الصفر حين تتحرر من منطق التراكم الفردي الجامح وتعيد تنظيم طاقاتها على نحو جماعي. يكفي أن نتأمل كيف انتقلت دول فقيرة وممزقة داخلياً إلى مصاف القوى الصناعية خلال عقود قليلة بفضل التخطيط المركزي والاستثمار في الإنسان، حيث تحوّل التعليم إلى سلاح، والبحث العلمي إلى قوة دفع، والمساواة الاجتماعية إلى رافعة إنتاجية.
إنّ النقد الذي يوجّه إلى الماركسية غالباً ما يركز على إخفاقاتها السياسية أو على التشوهات البيروقراطية التي نمت في بعض تجاربها، غير أن هذا النقد يتغافل عن جوهر الفكرة، أي عن أن الإنسان العادي حين يوضع في قلب العملية الاقتصادية يتحرر من أن يكون مجرد ترس في آلة الرأسمال. فالزراعة التي كانت تعاني التبعثر والضعف، تحولت بفعل التنظيم الجماعي إلى قوة قادرة على إطعام الملايين. والصناعة التي كانت حكراً على الدول الكبرى، غدت قطاعاً قادراً على إنتاج التكنولوجيا وغزو الفضاء. هذا التحول لم يكن ممكناً من دون فلسفة اقتصادية تعيد تعريف الثروة لا باعتبارها ملكية خاصة، بل كنتاج اجتماعي يجب أن يعود نفعه إلى المجموع.
الجانب الأكثر عمقاً في التجربة الماركسية هو إصرارها على أن العدالة الاقتصادية ليست عائقاً أمام النمو، بل هي شرطه الأول. ففي ظل الرأسمالية، غالباً ما يُطرح التناقض بين الكفاءة والعدالة، حيث يفترض أن يقلل توزيع الثروة الحوافز. أما الماركسية فقد أثبتت أن العدالة، حين تتحقق بوسائل عقلانية، تمنح الإنسان دافعاً أعمق للإنتاج لأنها تربطه بمصير جماعته لا بمصالحه الأنانية فقط. هذا البعد الأخلاقي هو الذي مكّن مجتمعات بكاملها من تجاوز مراحل التخلف والانتقال إلى مواقع متقدمة في البحث العلمي والتصنيع والتسليح.
وإذا كانت الرأسمالية قد أعادت تشكيل العالم عبر الأسواق المفتوحة والتجارة العالمية، فإن الماركسية تركت أثراً لا يقل أهمية، لقد منحت الشعوب المستضعفة لغة جديدة للمطالبة بحقها في التنمية والكرامة. إن القناعة بأن الثروة حق مشترك قابل لإعادة التوزيع، ورفض اعتبار احتكارها من قبل القلة قدراً، كانت بذرة الانتفاضات الاجتماعية وحركات التحرر وتبني بدائل اقتصادية في أرجاء العالم الثالث. بهذا المعنى، فإن التجربة الماركسية لم تؤثر في اقتصادات الشعوب التي طبقتها فحسب، بل هزت وجدان الإنسانية، وأجبرت النظام الرأسمالي نفسه على إصلاح ذاته جزئياً عبر دولة الرفاه والضمانات الاجتماعية، خشية أن تتسع جاذبية البديل الاشتراكي.
لا يمكن للمنصف أن يغفل الأخطاء التي وقعت فيها بعض التجارب الماركسية، لكن النقد الموضوعي لا يقود إلى إعدام الفكرة، بل إلى إدراك أن هذه الفلسفة الاقتصادية كانت، وما زالت، أحد أعظم محاولات الإنسان لتأسيس اقتصاد أخلاقي عقلاني، لأنها كشفت للعالم أن الإنتاج ليس غاية في ذاته، بل وسيلة لخدمة حاجات البشر، وأن التنمية ليست مجرد أرقام في ميزانيات، بل بناءً متكاملاً للعدالة والوعي والقوة.
إن أثر التجربة الماركسية في تطور ونمو اقتصاد الشعوب سيظل قائماً ما بقي سعي الإنسانية للخروج من استغلال الأسواق، وما بقيت تساؤلات العدالة والكرامة والحرية الاقتصادية بلا جواب نهائي. لقد أثبتت التجربة أن التاريخ لا يتوقف عند نمط إنتاج واحد، وأن الشعوب قادرة، عبر الوعي والتنظيم، أن تفتح آفاقاً جديدة للاقتصاد تعيد للإنسان مكانته الأولى، كخالق للثروة ومالكها الحقيقي، لا كعبد لرأس المال.
ولعل التجربة السوفيتية تشكل المثال الأكثر وضوحاً على قدرة النظرية الماركسية على تحويل أمة شبه زراعية، مسحوقة بفعل الحروب والتخلف، إلى قوة صناعية عظمى خلال أقل من نصف قرن. فالاقتصاد الروسي عشية الثورة البلشفية كان هشاً، يعتمد على فلاحة تقليدية ويعاني تركة ثقيلة من النظام القيصري. لكن مع سياسات التخطيط المركزي، ومع الخطة الخمسية الأولى التي أطلقها ستالين عام 1928، انطلقت عملية تحديث صناعي وزراعي غير مسبوقة. ففي غضون عقود قليلة، انتقلت روسيا من بلد مستورد للآلات إلى بلد يصنع الصواريخ والمفاعلات النووية، ويتمكن من إرسال أول إنسان إلى الفضاء. ولم يكن هذا الإنجاز مجرد ترف علمي، بل كان دليلاً على أن فلسفة الاعتماد على القدرات الجمعية وتوجيهها وفق خطة مركزية يمكن أن تحقق قفزات نوعية في مجالات لا تجرؤ الرأسمالية على المغامرة فيها دون ضمانات ربحية.
وإذا ما انتقلنا إلى التجربة الصينية، فإنها تقدم صورة مغايرة في تفاصيلها وإن ظلت وفية للأساس الماركسي في توجيه الاقتصاد نحو المصلحة العامة. فقد خرجت الصين من حقبة استعمارية مريرة وانقسامات داخلية مدمرة، لكنها اختارت منذ انتصار الثورة عام 1949 أن تبني اقتصادها على قاعدة المساواة وتحرير الفلاحين من عبودية الإقطاع. ومع الإصلاحات اللاحقة التي قادها ماو ثم دينغ شياو بينغ، تبلورت صيغة مختلطة، جمعت بين التخطيط المركزي والانفتاح الجزئي على آليات السوق، دون التخلي عن روح الماركسية التي تعتبر الدولة مسؤولة عن توجيه التنمية وتوزيع ثمارها بعدالة. والنتيجة أن الصين، التي كانت ترمز إلى الفقر والجوع في الخمسينيات، أصبحت في غضون عقود قليلة القوة الصناعية الأولى في العالم، ومختبراً هائلاً للتكنولوجيا والإنتاج. هذا التحول لا يمكن فصله عن الرؤية الماركسية التي اعتبرت أن التنمية ليست امتيازاً للنخب، بل حقاً للجماهير الواسعة.
أما في أوروبا الشرقية، فإن التجارب الماركسية، رغم تباينها، أسست لنموذج اقتصادي متماسك مكّن شعوباً عانت الفقر والحروب من تحقيق مستويات معيشية مستقرة. فبولندا، وتشيكوسلوفاكيا، وألمانيا الشرقية، كانت مجتمعات مدمرة بعد الحرب العالمية الثانية، لكنها بفضل النماذج الاشتراكية تمكنت من إعادة بناء صناعاتها وبناها التحتية بسرعة، ومنح شعوبها تعليماً وصحة مجانّيين، ومساواة اجتماعية حدّت من الفوارق الطبقية التي كانت متفشية في أوروبا الرأسمالية. بل إن بعض هذه الدول، رغم سقوط المنظومة الاشتراكية لاحقاً، ما زالت حتى اليوم تجني ثمار تلك المرحلة في قوة البنية التحتية والنظام التعليمي والصحي الذي تأسس في ظل الماركسية.
إن استحضار هذه الأمثلة التاريخية يبيّن أن التجربة الماركسية لم تكن وهماً أيديولوجياً، بل مشروعاً واقعياً حمل في طياته قدرة هائلة على تحويل المجتمعات وتحرير طاقاتها الكامنة. وإذا كان البعض يصر على رؤية المآلات السياسية وحدها، فإن القراءة الموضوعية لا بد أن تستحضر أن هذه التجارب صنعت قوى اقتصادية وصناعية كبرى من العدم تقريباً، وأنها أعادت تعريف معنى النمو لا كمسار ربحي، بل كمسار إنساني يضع العدالة في قلب العملية الاقتصادية.
وعند المقارنة بين أثر الماركسية في آسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط من جهة، وأثرها في المجتمعات الأوروبية الصناعية من جهة أخرى، يتضح تمايز عميق في الوظيفة التاريخية لكل تجربة. ففي آسيا، مثلاً في الصين وفيتنام وكوريا الشمالية، كانت الماركسية بمثابة مشروع تحرر وطني واجتماعي في آن واحد. فقد خرجت هذه الدول من استعمار طويل ومن فقر مدقع، فوجدت في الماركسية لغة لتعبئة الجماهير ووسيلة لتوحيد الشعب في مواجهة الإمبريالية. وكانت النتائج ملموسة: فيتنام، التي دمرتها الحروب الأمريكية، نجحت في بناء قاعدة صناعية وزراعية صلبة جعلتها اليوم من الاقتصادات الناشئة. أما كوريا الشمالية، رغم العزلة والضغوط، فقد طورت قدرات صناعية وعسكرية لم يكن ممكنا تصورها في بلد محدود الموارد.
وفي أمريكا اللاتينية، شكّلت كوبا أبرز تجسيد للتجربة الماركسية. فبرغم حصار اقتصادي استمر لعقود طويلة، تمكنت كوبا من بناء نظام صحي وتعليمي يعدّ من بين الأفضل في العالم، وأثبتت أن الماركسية ليست مجرد خطاب سياسي بل نظام قادر على حماية المجتمع وتطويره حتى في أقسى الظروف. التجربة الكوبية منحت شعوب القارة نموذجاً ألهم حركات ثورية في تشيلي ونيكاراغوا والبرازيل، مؤكدة أن العدالة الاجتماعية يمكن أن تكون محركاً للتنمية حتى في مواجهة الإمبراطوريات الاقتصادية.
أما في الشرق الأوسط، فإن تأثير الماركسية كان أكثر التباساً، إذ لم تتبلور أنظمة ماركسية مستقرة طويلة الأمد، لكن الفكرة تركت أثراً عميقاً في الحركات التحررية والنقابية والفكرية. ففي العراق، وسوريا، واليمن الجنوبي، تجسدت محاولات جادة لتطبيق بعض مبادئ الاقتصاد الاشتراكي، من تأميم النفط إلى الإصلاح الزراعي، وهي خطوات كانت تعكس روح الماركسية في تمكين الشعوب من السيطرة على ثرواتها. ورغم أن هذه التجارب لم تستمر طويلاً، إلا أنها أسست لوعي اجتماعي رافض لهيمنة الرأسمال الأجنبي ومطالب بالعدالة الاقتصادية.
وفي المقابل، نجد أن أثر الماركسية في أوروبا الصناعية كان مختلفاً من حيث الجوهر. فهنا لم تكن الماركسية مجرد مشروع للتحرر من الاستعمار أو للفكاك من التخلف، بل كانت تحدياً مباشراً لبنية الرأسمالية المتقدمة نفسها. لقد أجبرت الماركسية في أوروبا الغربية القوى الرأسمالية على إعادة النظر في سياساتها الاقتصادية والاجتماعية، فظهرت دولة الرفاه والضمانات الصحية والتعليمية، وجرى تعزيز حقوق العمال والنقابات. بمعنى آخر، حتى حين لم تُطبق الماركسية كنظام اقتصادي شامل، فقد فرضت نفسها وأجبرت الرأسمالية على الاعتدال والإصلاح.