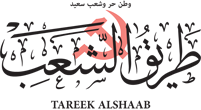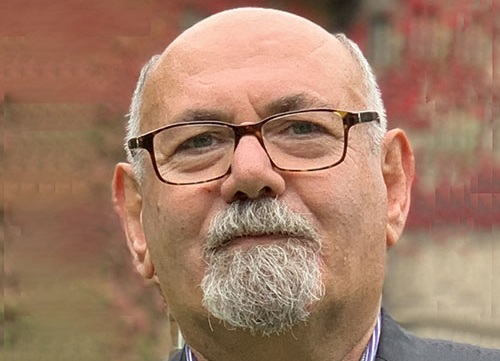كان ذلك قبل زمن طويل، يوم سمعنا بكلمة بروليتاري من صديق ظل يكررها بشغفِ منْ تَعلم لفظ كلمة أعجمية بعد طول عناء. لم يكن سهلاً عليّنا نطقها ناهيك عن معرفة معانيها. وربما دفعنا ضجرنا من تكراره العبثي لها، للبحث في أصلها وفصلها، فعرفنا بأنها تعني كل منْ يضطر لبيع قوة جسده ليخلق بها فائض قيمة، وكل من تفقده الملكية الخاصة قدرته على اختيار عمله والتمتع بجوهره الانساني، لتختفي عندئذ حريته ويتوه في اغتراب مقيت. وعرفنا بأنها تعني منْ تُسلب منه الخيرات المادية التي ينتجها ويُدفع قسراً لحافة القهر، على أن يبقى حياً ليواصل مضاعفة الأرباح التي يسلبها المتوحشون.
وكبرنا، واهتدينا إلى أن البروليتاريا مفتاح أحلامنا بالحرية والعدل، والطبقة الوحيدة القادرة على تحرير كل البشر من عبودية الرأسمالية، ليس لعاطفة انسانية نبيلة فحسب، بل لأن الصراع بينها كطبقة منهوبة، لا تملك شيئاً ولا تخسر في الثورة سوى أغلالها، وبين البرجوازية النهابة، هو المحرك الموضوعي للتطور الراهن، فإخترنا وحسُن اختيارنا.
ومضت السنون مثقلة بالعذاب وممتعة ببهاء الكفاح، وانهارت التجربة الاشتراكية الأولى، فجاء من أقصى اليمين أناس قالوا بالانتصار الحاسم للمستغِلين، وحاججوا بانتهاء الصراع، فالبروليتاريا تغيرت وتدنى وعيها بالانتماء الطبقي. وصّدق بعضنا هذه الفرية، فلجأوا لجبل التعاون الطبقي عسى أن يعصمهم. لكن، التناقض بين العمل ورأس المال، الناتج عن استلاب العمل المأجور، بقّي أساس كل التحولات التاريخية، وبقيّ تفعيله عبر تطوير متواتر للحريات يساعد في خلق هيمنة من تحت، حسب تعبير غرامشي، سبيلا للخلاص.
وأزهر وعينا، فعرفنا بأن وضوح الأمر لا يحجب ما حدث فيه من متغيرات، حين أدى تفكيك الصناعة التقليدية وهيمنة الثورة الصناعية الرابعة وعالم الرقمنة، لتغيير التعريف الكلاسيكي للبروليتاريا، التي باتت لا تضم رجالاً ببدلات زرقاء في الغرب، بل وايضاً، شغيلة دول الأطراف والنساء اللواتي بتنّ يشكلنّ 40 في المائة من قوام الطبقة. كما لم يعّد الخلاص من الاستغلال، مهمتها الوحيدة، بل وأيضاً الكفاح من أجل مساواة النساء بالرجال وإرغام رأس المال على دفع تكاليف إعادة الإنتاج الاجتماعي وجميع تدابير الإصلاح البيئي وأثمان الاستغلال المجاني للشعوب على مدى قرون.
ومضت السنون، وتعددت أراء اليساريين في التعامل مع هذه التحديات، فرأى بعضهم بأن النضال الطبقي يجب أن يُدمج ضمن أفق تحرري أوسع، يشمل قضايا النساء والعنصرية والبيئة. وأضاف آخرون للموقع الاقتصادي الذي كنا نحدد الطبقة على أساسه، تقسيمات اجتماعية مختلفة كالجنس والعرق، فيما رأى مفكرون بأن البروليتاريا باتت تضم المشتغلين بالرعاية والعمل المنزلي ممن تم تهميشهم في التحليلات الكلاسيكية. آخرون دعوا لاعتماد الأغلبية المحرومة من الرفاهية والمتضررة من تغير المناخ كقوة طبقية تعمل في ظل الرأسمالية المعرفية والرقمية، قوة متعددة الشرائح وعابرة للحدود القومية، فيما دعا البعض إلى إحياء دور الطبقات الشعبية في مجتمعات الأطراف لتحقيق سيادتها الاقتصادية وتحررها السياسي.
وإذا كان اختلاف الأراء رحمةً، إن أفضى للغد المرتجى، فأن دور البروليتاريا كحجر أساس في أي مشروع لتغيير النظام الرأسمالي، يبقى بحاجة لفهم جديد يتجاوز الأطر التقليدية، نحو أدوات تحليل جديدة تأخذ في الاعتبار التحولات البنيوية في العمل والتنظيم والمعرفة، وتكشف عن الترابط الوثيق بين استعادة مركزية الشغيلة، متحالفة مع الفئات الاجتماعية المناهضة للرأسمالية، وبين الهدف المشترك في أنسنة عالم يحكمه الاستغلال وتهدده الحروب.
مجداً عيد الشغيلة، وشكراً للذي علمنا حُسن الاختيار، حين حاول أن يعلمنا كيف ننطق مفردة "بروليتاري".